

عدم المساواة في المنطقة العربية
دوّّامة من الأزمات
اقرأها بالأرقام
استكشف لوحة المعلومات التفاعلية للحصول على تصورات ورؤى إحصائية مفصلة.
اقرأها بالأرقام
Inequality in the Arab region: Crisis upon crisis

تصدير
حمل عام 2023 في مطلعه بشائر للمنطقة العربية مع تواري شبح جائحة كوفيد 19 أخيراً، ممّهداً الطريق لعودتها إلى الحياة الطبيعية بعد ما قاسته من تحديات في عام 2022. وكان من المتوقع للمداخيل بأن ترتفع، وللأسعار بأن تنخفض.
غير أن هذا الارتفاع المتوقع في الرفاه العام لم يتحقق. بل شابت عام 2023 سلسلة تَتْرى من الأزمات. فمن الزلزال المدمر الذي ضرب الجمهورية العربية السورية، إلى تجدُّد النزاعات في السودان، والكوارث الطبيعية في المغرب وليبيا، اضطرت المنطقة إلى مقارعة العديد من التحديات. وظلت تقوّض نسيج مجتمعاتها واقتصاداتها في الوقت نفسه التهديدات الدائمة من قبيل الجفاف، وندرة المياه، والنزاعات، والتضخم الجامح، وعدم الاستقرار المؤسسي. وأدى التباطؤ الاقتصادي الناجم عن ذلك إلى تفاقم الفقر وتقييد قدرة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية، مما زاد من تعميق الانقسامات المجتمعية.
وغالباً ما كانت هذه الأزمات تتداخل، مؤديةً إلى سلسلة من التحديات المترابطة التي يطلق عليها تعبير «الأزمات المتشابكة». وكان تأثير هذه الأزمات المتشابكة مهولاً. وقد أدى إلى خسائر في الأرواح، وإلى جعل النزوح، والجوع، وتضاؤل فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم حقائق يومية بالنسبة للكثيرين. وقد تفاقمت أوجه عدم المساواة كثيراً، حيث تجشمت وطأة عواقبها الفئات المهمشة، ولا سيما الفقراء والشباب والنساء. وتعمل هذه الحلقة المفرغة من عدم المساواة على إدامة دورة التفاوتات المتعددة الأبعاد، على نحو يضخم مخاطر الأزمات في المستقبل.
وبالنسبة لسكان المنطقة، يمثل التغلب على المصاعب التي تُفرض عليهم تحدياً يومياً. وتتطلب قدرتهم على الصمود في مواجهة الشدائد الاهتمام والعمل. كما أن معالجة شواغلهم ليست واجباً أخلاقياً فحسب، بل إنها ضرورية لتعزيز الاستقرار في المنطقة.
بيد أن هذه الفوضى تحمل في طياتها فرصةٌ للعمل الجماعي. فمع دنوّ أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ثمة حاجة ملحة إلى تسريع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومما يبعث على التشجيع، أن المحافل العالمية الأخيرة، ومنها قمة أهداف التنمية المستدامة ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه واجتماعات مؤتمر الأطراف، قد أرست الأُسس للمضي قدماً. فمن تعزيز الآليات المالية إلى معالجة أوجه عدم المساواة، ثمة زخم ملموس نحو التغيير.
ويجب، أثناء السعي نحو إحداث هذا التغيير المنشود، إدراك العلاقة الترابطية الدورية بين الأزمات وعدم المساواة. كما يجب، عند تصميم التدخلات، إيلاء اهتمام دؤوب لكسر هذه الحلقة وصون المساواة في أوقات الأزمات.
وعلى الأجل القصير، يتعين على الجهات الفاعلة الوطنية والدولية إيلاء الأولوية لمسألتي المعونة الإنسانية الفورية والمساعدة الاجتماعية. ويجب دعمهما بتدابير استعداد قوية وتفعيلهما وفق آليات تمويل مرنة. ويمكن أن يؤدي اعتماد التكنولوجيا وإرساء الشراكات مع المنظمات غير الحكومية المحلية إلى تعزيز فعالية تقديم المعونة، ولا سيما للفئات الضعيفة.
أما على الأجل المتوسط، فثمة حاجة إلى تنفيذ خطط وتدابير شاملة للاستجابة للكوارث بغية تعزيز المساواة، مثل الضرائب التصاعدية وأطر التأمين الاجتماعي. والمهم هو ألّا يجري تحويل وجهة تمويل التنمية الطويلة الأجل أثناء الأزمات: فذلك يهدد بتفاقم أوجه عدم المساواة وإعاقة التقدم على الأجل الطويل.
ويضطلع المجتمع الدولي بدور حيوي على هذا الصعيد. فمن خلال توفير التمويل والدعم السريعين للبلدان المتأثرة بالأزمات، يمكن التخفيف من شدة الأزمات وتعزيز الأمن والاستدامة العالميين.
وفي مواجهة الشبكة المعقدة من الأزمات المتعددة وعدم المساواة، يكتسي العمل الاستباقي والمنسق أهمية قصوى. فمن خلال التضامن والالتزام المشترك فقط يمكن بناء مستقبل أكثر صموداً وإنصافاً للمنطقة العربية وخارجها.

رولا دشتي
الأمينة التنفيذية اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وكيلة الأمين العام
موجز تنفيذي
يتأثر العالم حالياً بمزيج من الأزمات البيئية والاقتصادية والمؤسسية المترابطة والمتعلقة بالنزاعات. ويمكن أن تتّحد هذه الأزمات لتحدث «أزمة متشابكة»: وهي ظاهرة مدمرة تولِّد فيها التفاعلات بين الأزمات الفردية مستوىً من الضرر يتجاوز التأثير التراكمي لكل أزمة بمفردها. وتمثل الأزمات المتشابكة تهديداتٍ شاملة على مختلف جوانب الحياة، مما يقوّض سبل العيش والنظم الاجتماعية. كما أنها تمثّل تحدياً لآليات الاستجابة الفردية والجماعية على حد سواء، وتبدّد ما أحرز سابقاً من تقدم وإنجازات في مجال التنمية المستدامة. ويقوّض ذلك تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ويؤدي إلى تفاقم الحرمان، ولا سيما لدى الفئات الضعيفة والمهمشة.
ويخلص تقرير عدم المساواة في المنطقة العربية في نسخته الثالثة هذه إلى أن المنطقة العربية جابهت على مدى السنوات التسع الماضية عدداً متزايداً من التحديات المتشابكة. ففي عام 2023 وحده، عانت المنطقة من ارتفاع أسعار الأغذية، وضغوط التضخم، وضغوط الديون، وضغوط خدمة الديون، واستمرار تزايد أعداد النازحين داخلياً واللاجئين، والزلازل، والفيضانات، وموجات الجفاف، وموجات الحر، وتجدُّد النزاع والحرب والاحتلال. ولم تتساوَ جميع البلدان في تأثرها بتلك الأزمات. كما لم تتساوَ في استجاباتها لها. وقامت بعض البلدان المتأثرة بأزمات متضافرة بدعم أسعار الأغذية، وتعزيز المؤسسات، والاستثمار في آليات الحد من مخاطر الكوارث والاستجابة لها التي حمت سكانها من الأزمات. أما استجابات البلدان الأخرى فكانت أقل فعالية، مما ترك سكانها فرائس للفقر والجوع والنزوح.
ويشير التحليل إلى مسار مثير للقلق. فهو يشير على وجه التحديد إلى أن المنطقة العربية تتجه نحو أزمة متشابكة. إذ يُتوقع أن تؤدي عواقب التطورات في عام 2023، بما في ذلك الحرب على غزة، إلى دفع المنطقة قاطبةً إلى أزمة متشابكة مستمرة. وإذا ما حدثت هذه الأزمة المتشابكة، فإنها تهدد بتفاقم أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد وتبديد المكاسب الإنمائية التي تحققت بشق الأنفس على مدى عقود من الزمن.
ويخلص هذا التقرير إلى أن الأزمات المتشابكة والأبعاد المتعددة لعدم المساواة مسألتان مترابطتان. فارتفاع مخاطر الأزمات المتشابكة يزيد من احتمال ارتفاع أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد. ومن شأن مزيجهما هذا أن يقوّض القدرة المجتمعية على الصمود ويزيد من آثار الأزمات، مما يضاعف من معاناة المهمشين بالفعل. فأوجه عدم المساواة والأزمات تعزز كل منهما الأخرى: فالأزمات تسبٍّب عدم المساواة وتكثفه، أما عدم المساواة فقد يؤدي إلى اندلاع الأزمات أو تفاقمها.
ويبرز التقرير التباين في الثروات بين البلدان في المنطقة العربية. فالبلدان المرتفعة الدخل لديها أدنى مستويات من عدم المساواة المتعدد الأبعاد وأقل تعرّضاً لمخاطر الأزمات؛ بل انخفض تعرضها للمخاطر في السنوات الأخيرة. وفي المقابل، فإن البلدان المنخفضة الدخل، التي تؤوي ربع سكان المنطقة، لديها مستويات أعلى من عدم المساواة المتعدد الأبعاد، وهي معرضةٌ بدرجة مرتفعة عموماً لمخاطر الأزمات المتشابكة. كما أن الوضع في البلدان المنخفضة الدخل آخذ في التدهور، سواء من حيث عدم المساواة أو مخاطر حدوث أزمة فيها. وتدنو البلدان المتوسطة الدخل في المنطقة، التي تؤوي ما يقرب من ثلثي سكان المنطقة، بسرعة من حالة الأزمة. وقد تمكنت حتى الآن من احتواء تزايد أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد. لكن هناك احتمال متنامٍ من أن يتحول تزايد مخاطر الأزمات فيها إلى تزايد عدم المساواة في المستقبل.
وتتفاقم أوجه عدم المساواة في الاقتصاد، وعدم المساواة بين الشباب، وعدم المساواة في الحصول على الغذاء في المنطقة العربية. أما عدم المساواة في الحصول على التكنولوجيا فيبدو أنه يسير على مسار أفضل. فقد تحققت مكاسب هائلة في مجال الحصول على التكنولوجيا حيث زاد الربط الشبكي في المنطقة العربية أكثر فأكثر.
ويمثل عدم المساواة بين الشباب تحدياً صعباً بوجه خاص لعدة أسباب. فقد ازداد التحصيل العلمي بين الشباب في المنطقة منذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة. لكن ذلك زاد من التفاوت بين مؤهلات الشباب والفرص المتاحة لهم. وبالإضافة إلى إهدار إمكانات الشباب، يهدد ذلك أيضاً بإدامة التفاوتات القائمة بل ومفاقمتها، مما يمثل خطراً طويل الأجل على المساواة المجتمعية الشاملة.
كما أن عدم المساواة يؤجج التطرف. فقد تُغرِّر الجماعات المتطرفة بالشباب الذين لديهم مؤهلات وليس لديهم وظائف وتعطيهم شعوراً بالكرامة والتقدير. فهي أحياناً توفر المزايا الاجتماعية والدخل. كما أنها تملأ الفراغ أحياناً في البيئات التي لا يتسنى فيها دائماً الاعتماد على الدولة لتحقيق العدالة، مما يعطي الناس شعوراً بالإنصاف الاقتصادي عندما تعجز الدولة عن توفيره.
ومن الواضح إذاً أن عدم المساواة في الاقتصاد، وعدم المساواة بين الشباب، وعدم المساواة في الحصول على الغذاء، وعدم المساواة في الحصول على الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية تمثل شواغل كبيرة. وإذا ما أُريد لها أن تتفادى الأزمات، فلا بد من تخصيص الموارد ووضع سياسات شاملة على وجه السرعة.
ولا يقتصر هذا التقرير عن عدم المساواة في المنطقة العربية، أسوةً بالتقريرين السابقين، على تحليل التحديات التي تواجه البلدان في المنطقة العربية فحسب. بل إنه يقدم حلولاً عملية في مجال السياسات من أجل العمل الإقليمي والتخطيط الوطني، ويدعو إلى الحد من أوجه عدم المساواة بين البلدان. والمهم هو أن هذه الحلول تنطلق من فرضية أن التخطيط الإنمائي يجب أن يراعي تلقائياً مخاطر الأزمات المستقبلية. ويقترح التقرير إدخال إصلاحات على الهيكل المالي العالمي لصالح البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على حد سواء، بما في ذلك إصلاحات لوائح الديون، وحقوق السحب الخاصة، ودور المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف. كما يقترح أيضاً زيادة التعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، واتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه على الصعيدين العالمي والإقليمي.
وعلى الصعيد الوطني، يطرح التقرير اتخاذ تدابير قصيرة ومتوسطة الأجل. فعلى الأجل القصير، لا بد من تنقيح سياسات حالات الطوارئ والحالات الاحترازية. ولا بد من وضع سياسات ضريبية لتمكين الاستجابات السريعة للأزمات، ويتعين على الهيئات الوطنية تحسين طريقة تنسيق استجابتها للأزمات، وتسخير الإمكانات الكاملة للنُهج التي تقودها المجتمعات المحلية والتكنولوجيات الجديدة. كما تكمن الشفافية بشأن الإنفاق الحكومي والمساعدات الإنسانية في صميم توصيات التقرير. وعلى الأجل المتوسط، يجب التركيز على السياسات الرامية إلى بناء القدرة على الصمود. وتشمل هذه السياسات إدخال خطط التأمين الاجتماعي الشاملة، وتحسين جودة التعليم، ودعم الشمول المالي، وتعميم تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. وكموضوع جامع، يوصي التقرير بأن تراعي السياسات الترابط الذي يعزز بعضه بعضاً بين التدابير الإنسانية والإنمائية وتدابير بناء السلام.
وتحتاج البلدان الأكثر ضعفاً والمتأثرة بالنزاعات إلى حلول مصممة خصيصاً بدرجة عالية. ويوصي التقرير على هذا الصعيد بالاستثمار في الوساطة وبناء السلام، بما في ذلك الضمانات الأمنية، التي تشكل الأسس الاجتماعية والاقتصادية للسلام. والمهم أنه يشدد على النُهج التي تحترم حقوق الإنسان وتسعى إلى تجنب إحداث مظالم في المستقبل. وهو يدعو إلى إشراك النساء والشباب والقادة المجتمعيين في مبادرات بناء السلام، وزيادة المشاركة في صنع القرار. وأخيراً، يلفت التقرير الانتباه إلى قيمة استخدام المانحين للنُظم المحلية من أجل تقديم المعونة في البلدان المتأثرة بالنزاعات. فعندما يستخدم المانحون النظم المحلية، فإن ذلك يعزز قدرة المجتمع على الصمود ويصون رأس المال البشري والمؤسسي. كما أنه يوفر قيمة أفضل مقابل المال.
وتتطلب الحلول المبتكرة في مجال السياسات التمويل. ومع أخذ ذلك بالحسبان، يختتم التقرير بقسم عن التمويل الوطني. وتركز التوصيات على اعتماد سياسات ضرائب تصاعدية على الدخل والثروة والشركات؛ وتجنب فرض الضرائب غير المباشرة؛ وخفض تكلفة تحويلات المغتربين؛ وإرساء الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ والتصدي للتهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة. ويمكن لهذه التدابير، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالتمويل الدولي، أن توفر بسرعة حصةً كبيرةً من الموارد اللازمة للحد بدرجة كبيرة من عدم المساواة في المنطقة العربية.
مقدمة
تتفشى أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية على نطاق واسع في المنطقة العربية. لكنها ليست مشكلةً معزولة عن سواها. فالتفاوتات التي تمسّ المنطقة تتأثر تأثراً كبيراً بالأحداث الإقليمية والعالمية.
وقد كان لمختلف التطورات التي طرأت في عامي 2022 و2023 تأثيرٌ سلبي على المنطقة العربية. فالحرب في أوكرانيا مثلاً كان لها تأثيرٌ كبير على إمدادات الأغذية. إذ كانت المنطقة تعتمد، قبل اندلاع الحرب، اعتماداً كبيراً على واردات الحبوب من أوكرانيا. وفي عام 2022، تم إنشاء آلية – هي «مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب» – لتحقيق الاستقرار في شحنات الحبوب. واستوردت المنطقة نحو 13 في المائة من الحبوب بموجب الآلية عندما كانت قيد التشغيل؛ وارتفعت فيها أسعار الأغذية في المنطقة عندما تم تعليقها.
كما أثّر تعليق الآلية على المساعدات الإنسانية. فقبل الحرب، كانت أوكرانيا مصدَر 80 في المائة من القمح الذي يوزّعه برنامج الأغذية العالمي. وتقع بعض البلدان المتلقية الرئيسية للقمح الذي يقدمه البرنامج – اليمن والسودان والصومال – في المنطقة العربية. والآن، أدّت الأسعار المتزايدة إلى خفض كمية القمح التي يستطيع البرنامج شراءها. ونتيجة لذلك، اضطر البرنامج إلى تخفيض كمية الأغذية في حصص الإعاشة التي يقدمها إلى بعض البلدان. ففي الجمهورية العربية السورية، لم يعد البرنامج يقدم أي مساعدة على الإطلاق إلى 2.5 مليون شخص من أصل 5.5 مليون شخص كانوا يعتمدون عليه في السابق. كما أنه يكافح من أجل تقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال في المغرب والفيضانات في ليبيا في الآونة الأخيرة.
وقد ظل التضخم مرتفعاً بوجه عام في المنطقة العربية في عام 2023. وكانت هناك بعض الاستثناءات: فعلى الرغم من تقلب أسعار النفط، ظل التضخم في بلدان مجلس التعاون الخليجي منخفضاً بسبب السياسات النقدية والضريبية المتوازنة. غير أنه ظل مرتفعاً في البلدان الأخرى، ولا سيما في البلدان التي تعاني من نزاعات أو تحديات اقتصادية (عادةً ما تكون قائمة على العملة).
ولا تتساوى الأسر في شعورها بأثر التضخم المرتفع. فالأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل تعاني انخفاضاً أكبر في أجورها الحقيقية وقوتها الشرائية مقارنةً بالأسر المرتفعة الدخل التي قد تكتسب استثماراتها قيمة. ويزداد الوضع حدةً في البلدان التي تتحمل أعباء ديون مرتفعة. كما أن التضخم المرتفع يحدّ من قدرة الحكومات على اقتراض المزيد من الأموال، إما استجابةً لأزمة ما أو للحفاظ على الإنفاق الاجتماعي.
كما ظلت مستويات الديون في جميع أنحاء المنطقة العربية مرتفعةً نسبياً في عام 2023، على الرغم من أن بعض البلدان لديها مستويات ديون أعلى من غيرها. ففي البلدان العربية المرتفعة الدخل، حيث تدعم عائدات النفط الإنفاق العام، بلغ متوسط الدين العام 31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. غير أن متوسط مستوى الدين في البلدان المتوسطة الدخل بلغ 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. أما في البلدان المنخفضة الدخل، فقد بلغ المتوسط 83 في المائة. وبالإضافة إلى ارتفاع أعباء الديون، تدفع البلدان المنخفضة الدخل أيضاً أقساطاً أعلى على ديونها.
وفي عام 2023، أثّرت الكوارث الطبيعية على العديد من البلدان في المنطقة. فقد ضرب الجمهورية العربية السورية في شباط/فبراير 2023 زلزالٌ كارثي أثّر على 9 ملايين شخص. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 6,000 شخص قد لقوا حتفهم، وأصبح نحو 5 ملايين شخص بلا مأوى. وأدى النزاع المستمر إلى تفاقم الأزمة الإنسانية: فقد عقّد الجهود الرامية إلى تقديم المساعدة إلى 4.1 مليون شخص يعيشون في المجتمعات المحلية الضعيفة في شمال غرب الجمهورية العربية السورية ممّن يعتمدون بالفعل على المساعدات الإنسانية.
وشهد الصومال أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاماً وفيضاناتٍ مدمرة في آذار/مارس 2023، مما أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص من منازلهم. ونتيجة لذلك، بحلول تموز/يوليو 2023، واجه 6.5 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي وزادت حالات الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه.
كما اشتدت النزاعات في المنطقة العربية في عام 2023؛ وأصبحت البلدان المتضررة أكثر اعتماداً على الدعم الإنساني. وفي نيسان/أبريل 2023، أدى اندلاع النزاع في السودان إلى نزوح جماعي. وكان العديد من الأشخاص الذين أجبروا على الفرار قد نزحوا أصلاً بسبب النزاعات السابقة. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول تموز/يوليو 2023، نزح 2.9 مليون شخص، إما داخلياً أو إلى البلدان المجاورة.
كما شهدت المنطقة العربية طيلة صيف عام 2023 موجات حر متتالية وممتدة، أثّرت على الصحة العامة والزراعة والكهرباء. وانخفضت غلة الذرة بنسبة 5.5 في المائة، وتعرّض 37 مليون شخص آخرين لخطر الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض.
وفي أيلول/سبتمبر 2023، لقي أكثر من 11,000 شخص حتفهم جراء الفيضانات التي اجتاحت شمال شرق ليبيا. ونزح آلاف آخرون، ولا يزال 10,000 شخص في عداد المفقودين. وأدى افتقار ليبيا إلى القدرة الوطنية على الاستجابة للأزمة إلى جعلها تعتمد اعتماداً كبيراً على الدعم الخارجي والمساعدات الإنسانية في وقت كان فيه تقديم المساعدات الإنسانية العالمية منهكاً بالفعل.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2023، شهدت غزة أكثر مائة يوم دموية في نزاع كبير في القرن الحادي والعشرين. وصاحب إراقة الدماء انهيار اقتصادي كاسح. ونتيجة لذلك، أصبح اقتصاد غزة الآن أصغر مما كان عليه في عام 2000. وفي الأسبوعين الأولين من الحرب، قفز عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد من 45 في المائة إلى 96 في المائة.
وقد تزامن تصاعد النزاعات داخل المنطقة مع فترة أصبح فيها الاهتمام العالمي مشتتاً ومتدنياً على نحو متزايد بسبب العدد الهائل من الأزمات. كما تتزايد القيود على الظروف المالية العالمية، وبالتالي على تقديم المعونة. وقد تجلى هذا التحول في الاهتمام وتخصيص الموارد في انخفاض حجم المعونة الأجنبية المتاحة للاجئين والنازحين داخلياً. ونتيجة لذلك، يتلقى اللاجئون والنازحون داخلياً مبالغ أقل من مدفوعات التحويلات النقدية والغذائية، وتُستثمر مبالغ أقل في الخدمات الصحية والتعليمية. وتؤدي هذه العوامل إلى تفاقم أوجه عدم المساواة المركّبة التي يواجهها اللاجئون بالفعل.
وإذا ما اجتمعت في آنٍ معاً عواملُ بطء النمو الاقتصادي، وارتفاع التضخم، وارتفاع الديون، وتغيُّر المناخ، والنزاع والحرب والاحتلال، وعدم فعالية المؤسسات، ومحدودية القدرة على الصمود، فإنها غالباً ما تحدّ من قدرة الحكومات على الاستجابة للأزمات.
وللصدمات المتعددة تأثيرُ كبير ولا سيما على الأشخاص الأكثر ضعفاً الذين عادةً ما يكون لديهم عدد أقل من المِصدّات التي تمكّنهم من أن يحموا أنفسهم أو يتعافوا من آثار الصدمات. فعلى سبيل المثال، فإن فرص النازحين داخلياً واللاجئين، الذين يتأثرون أيضاً بالنزاع أو الحرب أو الاحتلال، أقلُّ في الحصول على الخدمات الأساسية والمنقذة للأرواح. أما الأطفال، فيتأثرون بصورة فادحة: فكثيراً ما تنقطع سبل حصولهم على التعليم ومواصلة تعلمهم، وأحياناً إلى أجل غير مسمى. وللفجوة في التحصيل العلمي التي يخلفها ذلك تأثير سلبي على فرص العمل المتاحة لهم في المستقبل، وتزيد من احتمال وقوعهم في براثن الفقر. وتتسم الحالة بشدة بالغة ولا سيما في الحالات التي تعاني فيها نسبة كبيرة من الأطفال من سوء التغذية، كما في اليمن والصومال.
ويتناول تقرير عدم المساواة في المنطقة العربية في نسخته الثالثة هذه بالتفصيل العلاقة بين مخاطر الأزمات المتشابكة وأوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد. ويتبع النهج عينه الذي اتبعته نسختاه السابقتان اللتان بحثتا تحديات بطالة الشباب وانعدام الأمن الغذائي في المنطقة العربية. ويحلل التقرير التحديات التي تفرضها الأزمات المتعددة المتداخلة التي تواجه المنطقة العربية، وتأثيرها على عدم المساواة. ويقيّم مشكلة أوجه عدم المساواة المتعددة في المنطقة من منظورات مختلفة، ويحلّل مدى تعرّض البلدان لمخاطر الأزمات، ويدرس العلاقة بين الأزمات وأوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد. ويختتم التقرير، أسوةً بسابقيه، بحلولٍ عملية في مجال السياسات تهدف إلى الحد من أوجه عدم المساواة.
وتتناول فصول التقرير الخمسة العلاقة بين عدم المساواة ومخاطر الأزمات في المنطقة العربية استناداً إلى إطار بيانات مبتكر (الملحق 1). إذ يستهل الفصل التمهيدي بلمحة عامة عن الاتجاهات الرئيسية، بما في ذلك أثر التحوّلات العالمية على بلدان المنطقة.
ويأتي الفصل الأول بتقييم لظاهرة أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد، باستخدام إطار مبتكر وُضِع لجمع البيانات المتعلقة بتسعة أنواع من عدم المساواة: في الاقتصاد؛ وبين الجنسين؛ وبين الشباب؛ وفي الحصول على الرعاية الصحية؛ وفي الحصول على التعليم؛ وفي الحصول على الحماية الاجتماعية؛ وفي الحصول على الغذاء؛ وفي الحصول على التمويل؛ وفي الحصول على التكنولوجيا.
ويتناول الفصل الثاني العوامل التي تحوّل مجموعة من الأزمات إلى أزمة متشابكة. ويبين التحليل مخاطر حدوث أزمة باستخدام أربعة مجالات رئيسية للمخاطر: المناخ؛ والنزاع والحرب والاحتلال؛ والاقتصاد؛ والمؤسسات. ثم يقيّم درجة مواجهة البلدان العربية للأزمات المتداخلة.
ويشمل الفصل الثالث المناقشات السابقة حول إطار أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد ومخاطر الأزمات المتشابكة لتقييم العلاقة بين الأزمات وعدم المساواة على الصعيد الإقليمي ودون الإقليمي والوطني.
ويقيّم الفصل الرابع العلاقة بين بيئة الأزمات المتشابكة الناشئة والتنمية المستدامة الطويلة الأجل. ويقدِّم دراسات حالة متعمقة عن أوجه عدم المساواة داخل البلدان باستخدام البيانات الإحصائية المتكاملة وبيانات رصد الأرض، وبيانات التصورات العامة، والمقابلات مع صانعي السياسات في المنطقة العربية. وهو يحتوي على تحليل مفصل للأوضاع التي يواجهها كل من لبنان والمغرب واليمن والبحرين. ويخلص هذا التحليل إلى أن الاستجابة للأزمات القصيرة الأجل كثيراً ما تحوّل وِجهة الموارد بعيداً عن الأهداف الإنمائية الطويلة الأجل والاستدامة البيئية.
أما الفصل الخامس فيقترح في الختام حلولاً في مجال السياسات قد تثبت فعاليتها في حقبة الأزمات المتشابكة الناشئة.
1. أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد في المنطقة العربية
الرسائل الرئيسية
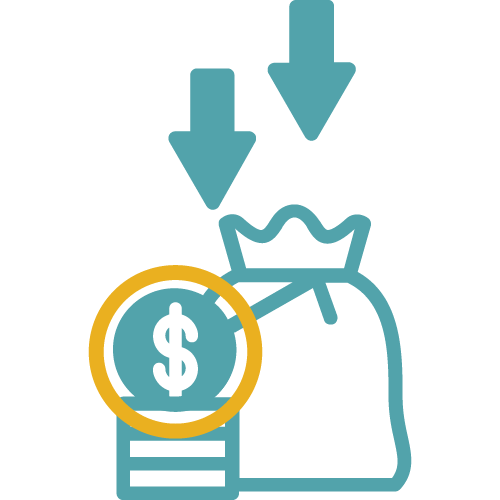
في عام 2022، كان 52 في المائة من سكان المنطقة العربية يرون أن الظروف الاقتصادية تزداد سوءاً.
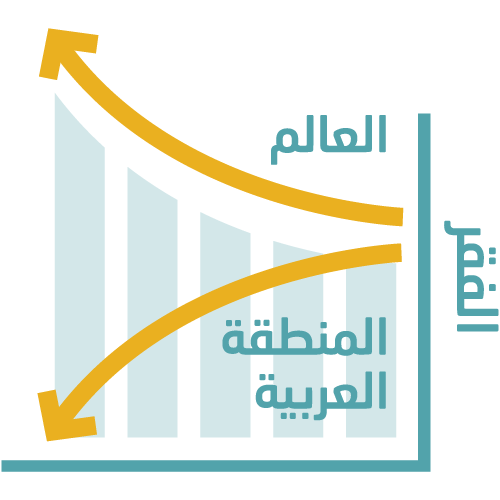
المنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة في العالم التي تتزايد فيها معدلات الفقر، فترتفع معها معدلات عدم المساواة.
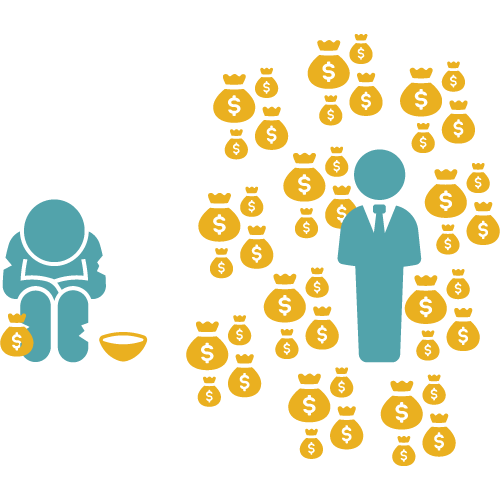
يمتلك أغنى 10 في المائة من سكان المنطقة العربية 44 ضعفاً من متوسط ثروة الفرد مقارنةً بأفقر 40 في المائة من سكانها.
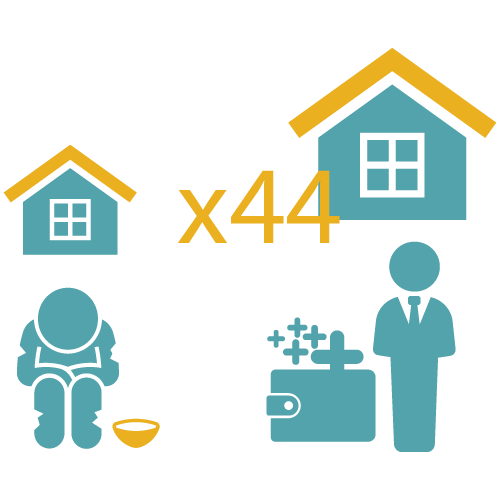
ارتفعت أوجه عدم المساواة في الثروة في المنطقة العربية ارتفاعاً حاداً منذ عام 2020، بعد انخفاضها في العقد الماضي. ففي عام 2020، استأثر أغنى 1 في المائة من السكان بحصة إجمالية من الثروة بلغت 43 في المائة؛ ثم ارتفعت حصتهم في عام 2022 إلى 44 في المائة.
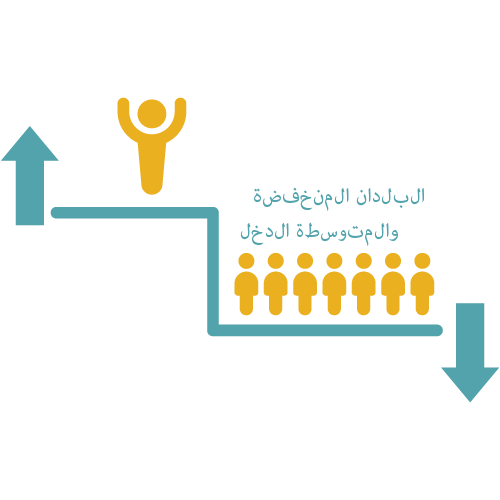
ازدادت أوجه عدم المساواة في الثروة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
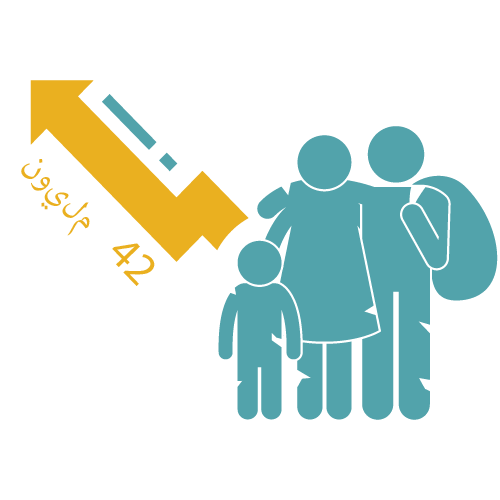
ازداد عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع في المنطقة العربية بمقدار 42 مليون شخص بين عامي 2015 و2023.
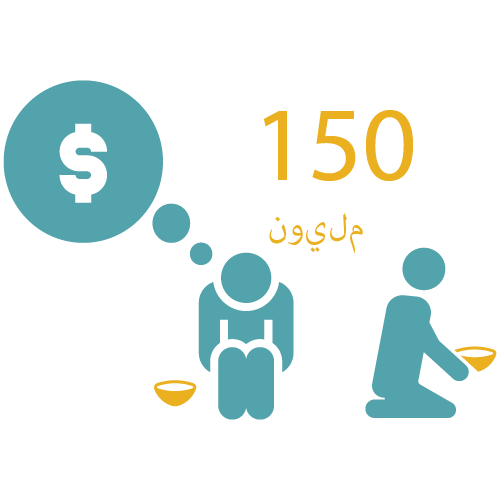
يعاني 150 مليون شخص من سكان المنطقة العربية من الفقر، منهم 85 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع.
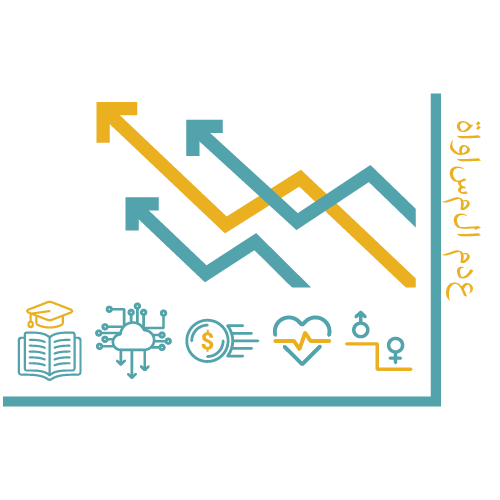
انخفضت أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد في مجالات الحصول على التمويل، والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، والمساواة بين الجنسين.
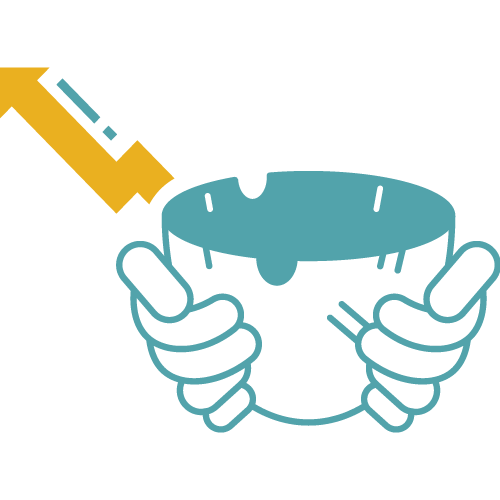
ازدادت أوجه عدم المساواة في الحصول على الغذاء بين عامي 2015 و2021 في كل مجموعات البلدان في المنطقة العربية.

ازدادت أوجه عدم المساواة بين الشباب بين عامي 2015 و2021 في 18 بلداً من بلدان المنطقة العربية.
مقدمة موجزة عن عدم المساواة
يرى سكان المنطقة العربية أكثر فأكثر أن أوجه عدم المساواة تمثل مشكلة، وأنها آخذة في الازدياد (الشكل 1). وبصرف النظر عن مستوى عدم المساواة المطلق، يمكن أن يكون للتصورات السلبية عنها تأثير ضارٌ على سلوك الناس وصنع القرار. وقد أفاد أكثر من ثلاثة أرباع السكان في الأردن ومصر ولبنان بأن الفجوة بين الأغنياء والفقراء قد اتسعت في غضون عام واحد فقط.
ويرى العديد من الناس في المنطقة أيضاً أن أوضاعهم تزداد سوءاً، الأمر الذي يضر على نحو خاص بالتماسك الاجتماعي والاستقرار. ووفقاً لبيانات مؤسسة غالوب، شهد عام 2022 نقطة تحول في مستويات التفاؤل لدى الجمهور. وفي ما مضى، أعرب معظم الناس في المنطقة عن تفاؤلهم بشأن الظروف الاقتصادية في منطقتهم. ففي عام 2015 مثلاً، ذكر 55 في المائة من المجيبين في الاستطلاع أن الظروف الاقتصادية في المنطقة آخذة في التحسن. ولكن في عام 2022، ولأول مرة، أعرب غالبية المجيبين عن آراء متشائمة: فقد ذكر 52 في المائة منهم أن الظروف الاقتصادية تزداد سوءاً. كما شهد العام كذلك ذروةً جديدةً في نسبة السكان العرب الذين يجدون صعوبة بالغة في العيش على دخلهم الحالي (23 في المائة).
الشكل 1.نتائج الباروميتر العربي – الدورة السابعة (2021-2022) (كنسبة مئوية)
وقياساً على عدم المساواة في الدخل وحده، فإن المنطقة العربية هي الأكثر تفاوتاً في العالم. ويعزى عدم المساواة هذا بجزء منه إلى الاختلافات بين البلدان: فهناك فجوة واسعة بين البلدان المرتفعة الدخل في المنطقة وبلدانها المتوسطة الدخل والمنخفضة الدخل.
لكن عدم المساواة ليس مجرد مقياس للثروة النسبية. فهو يشمل أشكالاً متعددة ومتداخلة من الحرمان النسبي، بما في ذلك الحصول على الخدمات الأساسية والتمييز على أساس الجماعة. ولا تزال أوجه عدم المساواة الشديدة بين مختلف المناطق وبين المناطق الريفية والحضرية داخل البلدان تمثل تحدياً. فلا تزال الفوارق بين الريف والحضر تتزايد بسرعة، مع ما يترتب عليها من آثار جسيمة على المساواة: فالناس الذين يعيشون في المناطق الحضرية لديهم فرص أفضل للحصول على التعليم وخدمات الرعاية الصحية ممّن يعيشون في المناطق الريفية. كما أن أوجه عدم المساواة داخل المدن نفسها آخذة في الازدياد.
ولا بد لأي إطار يحلّل عدم المساواة من أن يشمل كلاً من أوجه عدم المساواة الرأسية (الاختلافات القائمة على الدخل والثروة بين الأفراد والأسر) وأوجه عدم المساواة الأفقية (التفاوتات القائمة على المجموعة التي تشمل نوع الجنس، والعرق، والإقامة في المناطق الحضرية والريفية، والديانة، وغيرها من الخصائص). ويبين الجزء المتبقي من هذا الفصل الإطار المبتكر لأوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد الذي وُضع خصيصاً لهذا التقرير.
ويتناول الإطار عدم المساواة عبر تسعة أبعاد، هي: عدم المساواة في الاقتصاد؛ وبين الجنسين؛ وبين الشباب؛ وفي الحصول على الرعاية الصحية؛ وفي الحصول على التعليم؛ وفي الحصول على الحماية الاجتماعية؛ وفي الحصول على الغذاء؛ وفي الحصول على التمويل؛ وفي الحصول على التكنولوجيا. وقد حُدِّد عدد من المؤشرات ذات الصلة تحت كل ركيزة، وحُسبت قيمة كل ركيزة على الصعيد الإقليمي ودون الإقليمي والوطني. ثم يُجمِّع الإطار كل مصادر عدم المساواة المحددة لإنشاء مقياس واحد لأوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد سنوياً لكل بلد، ويُعرض أيضاً على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي. (الملحق 1: قياس أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد).
1. لمحة عامة عن أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد
الشكل 2. أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد
المصدر: حسابات الإسكوا
شهدت جميع أنحاء المنطقة قاطبةً انخفاضاً طفيفاً في أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد بين عامي 2015 و2021. ويعزى هذا الانخفاض إلى الانخفاضات في البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل (الشكل 2). غير أن الحالة في البلدان المنخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاعات وأقل البلدان نمواً تخالف الاتجاه العام. فقد ازدادت فيها أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد التي كانت بمستوىً مرتفع أصلاً.
ويوضح الشكل 3 تغيُّر حالة أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد في المنطقة العربية بين عامي 2015 و2021. وأكثر أنواع عدم المساواة انتشاراً في كافة أنحاء المنطقة العربية هي عدم المساواة بين الشباب، وفي الحصول على الغذاء، وفي الحصول على التمويل (الشكل 4). وفي حين أن عدم المساواة في الحصول على التمويل آخذٌ في الانخفاض، فإن عدم المساواة بين الشباب وفي الحصول على الغذاء آخذان في الازدياد.
الشكل 3. رسم خرائط أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد
Fiscal positions in Arab countries (2020), Total revenue/GDP
Fiscal positions in Arab countries (2020), Total revenue/GDP
الشكل 4. العوامل المساهمة في أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد في عامي 2015 و2021
2. عدم المساواة في الاقتصاد
أصبح العالم في العقود الأخيرة أكثر فأكثر ترابطاً وأصبحت بلدانه المنخفضة الدخل أكثر ازدهاراً. ولذا فإن عدم المساواة في الاقتصاد بين البلدان يتراجع بوجه عام. غير أن المنطقة العربية تمثل استثناءً من هذا الاتجاه العام. فعدم المساواة بين بلدان المنطقة آخذ في الازدياد، حيث يختلف ازدهار بلدانها المرتفعة الدخل كالإمارات العربية المتحدة وقطر أكثر من أي وقت مضى عن ازدهار بلدانها المنخفضة الدخل كالصومال واليمن.
وحتى في بلدان العالم التي تزداد ازدهاراً، تتوزُّع فوائد هذا الازدهار أكثر فأكثر توزعاً غير متساوٍ، مما يؤدي إلى زيادة عدم المساواة في الاقتصاد داخلها. وينطبق ذلك على المنطقة العربية أكثر من سواها، فهي المنطقة الوحيدة في العالم التي تتزايد فيها معدلات عدم المساواة في الدخل والفقر. فبين عامي 2015 و2023، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر في المنطقة من 100 مليون شخص إلى 150 مليون شخص، أي بزيادة من 28 في المائة إلى 35 في المائة من سكان المنطقة. كما تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع من 34 مليون شخص في عام 2015 إلى 85 مليون شخص في عام 2023، أي بزيادة من 9 في المائة إلى 20 في المائة.
وفي عام 2015، شهدت البلدان العربية المرتفعة الدخل أعلى مستويات من عدم المساواة في الاقتصاد في المنطقة. وبين عامي 2015 و2021، كانت هذه هي المجموعة الوحيدة من البلدان التي شهدت انخفاضاً في عدم المساواة في الاقتصاد (الشكل 5). ومع ذلك، لا يزال المستوى الكلي لعدم المساواة في الاقتصاد مرتفعا، متجاوزاً متوسط المنطقة.
وبين عامي 2015 و2021، شهدت البلدان العربية المنخفضة الدخل زيادةً ملحوظةً في عدم المساواة في الاقتصاد، وهي زيادةٌ تعزى إلى حد كبير إلى ارتفاع معدلات الفقر. وقد أصبحت البلدان العربية المنخفضة الدخل نتيجةً لذلك أكثر مجموعات البلدان معاناةً من عدم المساواة في الاقتصاد في المنطقة.
الشكل 5. عدم المساواة في الاقتصاد
3. عدم المساواة بين الجنسين
يتخلف التمثيل الاقتصادي والسياسي للمرأة في المنطقة العربية عن المتوسط العالمي، ويعزى ذلك جزئياً إلى عدم تكافؤ فرص الحصول على الخدمات الأساسية والأعراف الاجتماعية. ويظهر مقياس عدم المساواة بين الجنسين المعتمد انخفاضاً طفيفاً بين عامي 2015 و2021. ويتجسد هذا الانخفاض في جميع مجموعات البلدان. وتبلغ أوجه عدم المساواة بين الجنسين أدنى مستوياتها في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، وتبلغ أعلى مستوياتها في البلدان المنخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاعات وأقل البلدان نمواً.
حققت البحرين وجزر القمر بعض أفضل القفزات على المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2023. فقد ارتقت البحرين بمقدار 18 مرتبة، وذلك من المرتبة 131 في عام 2022 إلى المرتبة 113 في عام 2023، وذلك بفضل التحسن الكبير في المشاركة السياسية والمشاركة والفرص الاقتصادية. وبحلول عام 2023، شغلت النساء 20 في المائة من المقاعد البرلمانية و22 في المائة من المناصب الوزارية في البحرين، مقابل 15 في المائة من المقاعد البرلمانية و5 في المائة من المناصب الوزارية في عام 2022. وفي الميدان الاقتصادي، تضاعف الدخل المقدَّر الذي تكسبه النساء من 18,000 دولار في عام 2022 (مقابل 54,000 دولار للرجال) إلى 36,000 دولار في عام 2023 (مقابل 57,000 دولار للرجال).
أما جزر القمر فقد ارتقت بمقدار 20 مرتبة على المؤشر، وذلك من المرتبة 134 في عام 2022 إلى المرتبة 114 في عام 2023، ويعزى ذلك بالكامل تقريباً إلى التحسن الكبير في المشاركة الاقتصادية للمرأة. ففي عام واحد فقط، حققت جزر القمر زيادةً في مشاركة الإناث في القوى العاملة من 32 في المائة في عام 2022 (مقابل 55 في المائة للرجال) إلى 41 في المائة في عام 2023 (59 في المائة للرجال)، وحققت التكافؤ بين الجنسين في نسبة المشرّعين وكبار المسؤولين والمديرين من النساء (49 في المائة، مقابل 26 في المائة في عام 2022).
الشكل 6. عدم المساواة بين الجنسين
4. عدم المساواة بين الشباب
الشباب هم من أكثر الفئات حرماناً في المنطقة، مع أنهم من أكبر مجموعاتها السكانية عددا. فهناك نحو 110 مليون من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً في المنطقة العربية. وهم يمثلون نحو 30 في المائة من السكان. وهؤلاء الشباب أكثر وأكثر تعلماً: فقد ارتفع مثلاً معدل التحاقهم بالتعليم العالي من 31 في المائة إلى 35 في المائة بين عامي 2015 و2021. ولكنهم أصبحوا أيضاً أكثر تهميشاً من الفرص السياسية والاقتصادية الحقيقية. ويمثل هذا الإقصاء مخاطر كبيرة على التماسك الاجتماعي في المنطقة.
ومعدل بطالة الشباب في المنطقة العربية هو الأعلى في العالم. فقد وصل في عام 2021 إلى 26 في المائة، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 15 في المائة. وتتأثر الشابات تأثراً بالغاً: حيث إن 42 في المائة منهن في جميع أنحاء المنطقة عاطلات عن العمل. كما أن 85 في المائة من الشباب في المنطقة العربية ممن لديهم وظائف يعملون بصورة غير نظامية. وهذا يزيد من ضعفهم ويقوض إمكاناتهم الإنتاجية.
ويواجه الشباب في العديد من بلدان المنطقة حواجزَ متزايدة أمام مشاركتهم السياسية. فمتوسط عمر البرلمانيين في جميع أنحاء المنطقة آخذ في الازدياد. والعديد من البلدان العربية لديها برلمانيون تزيد أعمارهم عن 90 عاماً. بيد أن الجزائر والبحرين يمثلان الاستثناء: إذ تقل أعمار 46.4 في المائة و42.5 في المائة من أعضاء البرلمان فيهما عن 45 عاما. وإذا لم يتم إشراك الشباب في العمليات السياسية، فقد يزداد احتمال تهميشهم.
وبين عامي 2015 و2021، ازدادت أوجه عدم المساواة بين الشباب في جميع أنحاء المنطقة العربية قاطبة. وكانت هذه الزيادة جليةً بوجه خاص في البلدان المنخفضة الدخل.
الشكل 7. عدم المساواة بين الشباب
أما مجموعة البلدان الوحيدة التي انخفضت فيها أوجه عدم المساواة بين الشباب فهي البلدان العربية المرتفعة الدخل. بيد أن ذلك الانخفاض يعزى بالكامل إلى المملكة العربية السعودية التي زادت فيها مشاركة الشباب في سن 25-29 عاماً في القوى العاملة من 13 في المائة فقط في عام 2015 إلى 25 في المائة في عام 2021. كما شهدت الجزائر انخفاضاً ملحوظاً في أوجه عدم المساواة بين الشباب يعزى إلى انخفاضٍ حادٍ في متوسط عمر البرلمانيين (الشكل 8).
الشكل 8. عدم المساواة بين الشباب على الصعيد الوطني
أوجه عدم المساواة بين الشباب في المنطقة العربية أعلى بكثير مما هي عليه في بقية العالم. وهي في أدنى مستوياتها في البلدان المرتفعة الدخل في المنطقة. ولكنها حتى في هذه البلدان لا تزال تتجاوز كثيراً متوسطها العالمي.
وفي عام 2021، بلغ المتوسط العالمي لمعدل بطالة الشباب 15.9 في المائة. أما في المنطقة العربية، فقد بلغ هذا المعدل 26.8 في المائة. وحتى في البلدان العربية المرتفعة الدخل، ظل متوسط معدل بطالة الشباب البالغ 20.2 في المائة أعلى بكثير من المتوسط العالمي.
وتبين هذه الأرقام بوضوح كيف أن الشباب في المنطقة العربية يواجهون مخاطر أكبر من معاصريهم في بقية العالم من التخلف عن الركب في بحثهم عن الفرص بعد التعليم.
5. عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية
يمكن أن تؤثر أوجه عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية تأثيراً شديداً على قدرة الناس على المشاركة مشاركةً حقيقيةً في المجتمع والاقتصاد. فالأشخاص الذين يعانون من الفقر مثلاً أقل قدرةً على شراء الأغذية المغذية والحصول على الرعاية الصحية الجيدة، مما يزيد احتمال أن تكون حصائلهم الصحية سلبية. وقد لا يتمكن العمال غير النظاميين من الحصول على التأمين الصحي، وقد تقل فرص حصول سكان الريف على خدمات الرعاية الصحية الجيدة.
وقد طرأ تحسّن طفيف على حالة عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة العربية قاطبةً منذ عام 2015، لكن مع وجود اختلافات كبيرة بين مجموعات البلدان
(الشكل 9). ولدى البلدان العربية المرتفعة الدخل عموماً أدنى مستويات عدم مساواة في الحصول على الرعاية الصحية، وقد طرأ تحسن في كل من البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل منذ عام 2015. أما في البلدان العربية المنخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاعات والأقل نموا، فتواصل أوجه عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية ارتفاعها. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة احتمال إنفاق الأفراد على الرعاية الجراحية، وانخفاض الإنفاق الحكومي على الصحة.
الشكل 9. عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية
6. عدم المساواة في الحصول على التعليم
تتسبب أوجه عدم المساواة في الحصول على التعليم في زيادة أوجه عدم المساواة الأخرى. كما أن لها تأثيراً مدى الحياة على تحديد الحراك الاجتماعي للشخص. ويمكن أن تورَّث العواقب الناجمة عن ذلك من جيل إلى جيل.
وقد انخفضت أوجه عدم المساواة في الحصول على التعليم انخفاضاً طفيفاً في المنطقة العربية منذ عام 2015 (الشكل 10). ويعزى ذلك أساساً إلى الاستثمارات التي تقودها الحكومات والإصلاحات في قطاع التعليم بغية الحد من التغيب عن العمل، وتدريب المعلمين، وتقديم مناهج دراسية أعم.
وتبلغ أوجه عدم المساواة في الحصول على التعليم أدنى مستوياتها في البلدان المرتفعة الدخل، وأعلى مستوياتها في أقل البلدان نمواً. وقد انخفضت، بين عامي 2015 و2021، انخفاضاً ملحوظاً في البلدان المتوسطة الدخل. ويتجلى هذا الانخفاض في عدد كبير من المؤشرات في هذا التحليل، مما يدل على التزام واسع النطاق بتحسين أداء قطاع التعليم.
ويعد تعزيز المساواة في الحصول على التعليم أمراً أساسياً لتعزيز الحراك الاجتماعي والحد من العديد من أشكال عدم المساواة الأخرى. ومع ذلك، ينبغي أن تقابل تحسين المساواة في التعليم زيادةٌ في الفرص المتاحة للشباب بعد إتمامهم تعليمهم. ولما تتحقق هذه الزيادة وفي المنطقة العربية بعد.
الشكل 10. عدم المساواة في الحصول على التعليم
7. عدم المساواة في الحصول على الحماية الاجتماعية
يمكن أن يؤدي الحصول على الحماية الاجتماعية إلى تقليل احتمال أن تؤدي الصدمات الصحية والوظيفية والبيئية غير المتوقعة إلى دفع الناس وأسرهم إلى الفقر. كما يمكن أن يقلل من العديد من أشكال عدم المساواة الأخرى.
وهناك فجوة واضحة في المساواة في الحصول على الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء المنطقة العربية. ففي البلدان العربية المرتفعة والمتوسطة الدخل، فإن أوجه عدم المساواة في الحصول على الحماية الاجتماعية منخفضة وآخذة في التناقص. ولكنها مرتفعة جداً وآخذة في التزايد، وإن كان بصورة طفيفة، في البلدان المنخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاعات وأقل البلدان نمواً (الشكل 11).
الشكل 11. عدم المساواة في الحصول على الحماية الاجتماعية
في فلسطين، اعترفت الحكومة بالحماية الاجتماعية بوصفها أداةً حاسمة للتصدي لمخاطر دورة الحياة وتحديات الفقر التي يواجهها المجتمع الفلسطيني. وقد جعلت من تحسين الحماية الاجتماعية هدفاً رئيسياً من أهداف السياسات في إطار أجندة السياسات الوطنية (2017-2022). ومن خلال مبادرات المساعدة الاجتماعية المختلفة من قبيل البرنامج الوطني الفلسطيني للتحويلات النقدية، تقدم وزارة التنمية الاجتماعية المساعدات في شكل نقد وخدمات إلى أكثر من 115,000 أسرة فلسطينية محرومة.
وكان لهذه التدخلات أثر واسع. فعلى سبيل المثال، ارتفع عدد الأشخاص ممن تجاوزوا سن التقاعد في فلسطين وحصلوا على معاش تقاعدي ارتفاعاً كبيراً بين عامي 2015 و2021، وذلك من 8 في المائة إلى 66 في المائة. غير أن يعتمد النظام اعتماداً كبيراً على الدعم الخارجي. وفي السنوات الأخيرة، كثيراً ما أدى النقص في التمويل المقدم من الشركاء الحكوميين والإنمائيين إلى تأخيرات وتخفيضات في المدفوعات. فعلى سبيل المثال، لم يتمكن برنامج التحويلات النقدية من تقديم المساعدات طيلة معظم عام 2021.
ومن المتوقع أن تؤدي الحرب على غزة، التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى زيادة كبيرة في عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة. وسيزداد الأمر حدةً بسبب التخفيضات الحادة في تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والاضطرابات في تدفق المعونة الدولية.
وفي البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل، زاد عدد الأشخاص الذين يتلقون معاشاً تقاعديا، كما زاد الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية. ومع ذلك، فإن النسبة الإجمالية للسكان الذين يحصلون على الحماية الاجتماعية لم تتغير كثيراً. وقد يشير ذلك إلى أن المستفيدين من الحماية الاجتماعية يتلقون رعاية جيدة على نحو متزايد. ولكن في الوقت نفسه، لا تزال نسبة كبيرة من سكان المنطقة العربية محرومة من الحماية الاجتماعية.
أما في البلدان المنخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاعات وأقل البلدان نموا، فقد أظهرت جميع المؤشرات المرتبطة بالحماية الاجتماعية انخفاضاً عاماً بين عامي 2015 و2021. وإلى جانب عدم المساواة في الحصول على التعليم، فإن عدم المساواة في الحصول على الحماية الاجتماعية هو أكبر مصدر مشترك لعدم المساواة في أقل البلدان نمواً.
8.عدم المساواة في الحصول على الغذاء
يمثل الحصول على الغذاء مصدراً حادا ومتزايداً من مصادر عدم المساواة في المنطقة العربية. وفي عام 2021، كان 174 مليون شخص في المنطقة – 35 في المائة من السكان، بزيادة قدرها 12 مليون شخص عن العام السابق – يعيشون من دون إمكانية الحصول على الغذاء بصورة آمنة. فقلة إمكانية الحصول على الغذاء تجبر الناس وأسرهم على إنفاق وقتهم ومواردهم الشحيحة في البحث عن طعام آمن يأكلونه. وهذا يؤدي إلى استنفاد إنتاجيتهم ويقوّض فرصهم في الحصول على تعليم عالي الجودة أو العثور على عمل لائق. ويؤثر انعدام الأمن الغذائي عادةً على السكان الضعفاء أصلاً أكثر من غيرهم. كما أنه يؤدي في كثير من
الشكل 12. عدم المساواة في الحصول على الغذاء
الأحيان إلى تفاقم عدم المساواة بين الجنسين: فعادةً ما تقضي النساء وقتاً أطول في البحث عن الطعام. وكثيراً ما تكون النساء أيضاً آخر من يتناول الطعام أخيرا، إذ يؤْثِرن إطعام أسرهن أولا، لذا فإنهن يتأثرن أكثر بنقص الأغذية.
وقد اقترن تزايد عدم المساواة في الحصول على الغذاء بارتفاع أسعار الأغذية. وشهدت خمسة بلدان في المنطقة تضخماً في أسعار الأغذية تجاوز 60 في المائة في عام 2023، في حين شهد لبنان والجمهورية العربية السورية تضخماً في أسعار الأغذية من ثلاثة أرقام، بنسبة 138 في المائة ونسبة 105 في المائة على التوالي. وعدم المساواة في الحصول على الغذاء هو الشكل الوحيد من عدم المساواة الذي زاد في كافة فئات الدخل بين عامي 2015 و2021 (الشكل 12).
ويتجلى عدم المساواة في الحصول على الغذاء بوجه خاص في المنطقة العربية في البلدان المنخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاعات وأقل البلدان نمواً. أما في البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل، فقد تم التخفيف من عدم المساواة في الحصول على الغذاء إلى حد ما من خلال السياسات الضريبية الموسعة والبرامج الحكومية.
9. عدم المساواة في الحصول على التمويل
يمكن استخدام الحصول على التمويل لدعم ريادة الأعمال، ومراكمة الثروة، والنمو الاقتصادي. لكن هذه الإمكانيات ستقتصر على مَن هم الأكثر حظاً ما لم تتم إتاحة إمكانية الحصول على التمويل للجميع.
ومستويات عدم المساواة في الحصول على التمويل في المنطقة العربية مرتفعة، ولا سيما في البلدان المنخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاعات وأقل البلدان نمواً. ومع ذلك، فإن عدم المساواة في الحصول على التمويل آخذٌ في الانخفاض في جميع تصنيفات مجموعات البلدان في المنطقة (الشكل 13).
الشكل 13. عدم المساواة في الحصول على التمويل
10. عدم المساواة في الحصول على التكنولوجيا
توفر إمكانات هائلة في توسيع نطاق تقديم الخدمات إلى المجتمعات المحلية التي كانت تعاني من نقصها سابقاً. فيمكن استخدام التكنولوجيا مثلاً لتوسيع نطاق الشمول المالي، أو لتوفير الرعاية الصحية عن بُعد في المناطق التي يندر فيها الأخصائيون الطبيون. لكن هذه التطورات التكنولوجية، ما لم يستفد منها جميع السكان، قد تصبح مصدراً لمزيد من عدم المساواة.
وتتباين أوجه عدم المساواة في الحصول على التكنولوجيا تبايناً كبيراً في أنحاء المنطقة العربية، على الرغم من أنها تتحسن بوجه عام. ففي البلدان المرتفعة الدخل، تعد أوجه عدم المساواة في الحصول على التكنولوجيا منخفضةً جداً لأن سكانها يتمتعون باتصال جيد بشبكة الإنترنت. أما الزيادة الضئيلة المبينة في الشكل 14، فتعزى إلى انخفاض عدد اشتراكات الهاتف المحمول من متوسط قدره 1.7 إلى 1.4 اشتراك للشخص الواحد.
وشهدت البلدان المتوسطة الدخل والبلدان المتأثرة بالنزاعات انخفاضاً كبيراً في عدم المساواة في الحصول على التكنولوجيا بفضل تحسن اتصال سكانها بشبكة الإنترنت. أما في البلدان المنخفضة الدخل وأقل البلدان نمواً، فلا تزال أوجه عدم المساواة في الحصول على التكنولوجيا مرتفعة، مما يهدد بترك ملايين الأشخاص من دون اتصال بشبكة الإنترنت.
الشكل 14. عدم المساواة في الحصول على التكنولوجيا
2. مقارعة الأزمات المتشابكة
الرسائل الرئيسية

من عام 2015 إلى عام 2022، ازدادت مخاطر الأزمات المتشابكة في ثلثي بلدان المنطقة العربية.

لم يكن أي من البلدان المرتفعة الدخل في المنطقة العربية معرضاً في الفترة 2015-2022 لمخاطر الأزمات المتشابكة. لكن هذه المخاطر باتت تهدد بشدة كل بلد من بلدانها المنخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاعات بحلول عام 2022.

المخاطر المرتبطة بالمناخ هي حالياً المخاطر الأسرع نمواً في المنطقة العربية.

زادت المخاطر الاقتصادية بين عامي 2021 و2022. وتُعزى هذه الزيادة جزئياً إلى الزيادات في التضخم والديون وبطء نمو الناتج المحلي الإجمالي.
شهدت المنطقة العربية في السنوات الأخيرة أزمات متعددة. فقد عانت بعض بلدانها من الانهيار الاقتصادي، والتضخم الجامح، وتزايد أعباء الديون. وعانت بلدان أخرى من موجات الجفاف، والفيضانات، وموجات الحر نتيجة لتغير المناخ. وقد شهدت بعض البلدان عدم استقرار مؤسسي. كما عانت بلدان معينة من النزاع والحرب والاحتلال. وفي كثير من الحالات، تداخلت هذه الأزمات وعززت بعضها بعضاً، وتمخضت عن عواقب مدمرة. ويُطلق على هذه الظاهرة تعبير «الأزمة المتشابكة»: وهي سلسلة من الأزمات المترابطة التي يعزز بعضها بعضاً (الملحق 3: ما هي الأزمة المتشابكة وكيف تظهر؟).

يشير مفهوم «الأزمة المتشابكة» إلى حالة تتداخل فيها أزمات متعددة، وترتبط أسبابها وعملياتها معاً بصورة لا تنفصم لإحداث تأثيرات مركبة.
معهد دراسات التنمية
أ. قياس مخاطر الأزمات المتشابكة في المنطقة العربية
حُدِّدت أربعة مجالات للأزمات المحتملة في المنطقة العربية: المناخ؛ والنزاع والحرب والاحتلال؛ والاقتصاد؛ والمؤسسات. وقد حُسبت مخاطر الأزمات التي تحدث في كل من هذه المجالات على الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي، وصُنفت المخاطر في كل مجال على أنها مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة. ثم جُمِّعت هذه المخاطر لحساب المخاطر الكلية للأزمات المتشابكة. ومع أن إطار البيانات يقارن بين عامي 2015 و2021 فقط، فقد حُدِّثت مخاطر الأزمات بقدر أكبر حيثما أمكن ذلك. (الملحق 2: قياس مخاطر الأزمات المتشابكة)
1. مخاطر حدوث أزمة مناخية
ليس من المستغرب، مع تسارع تغير المناخ، أن تزداد مخاطر حدوث أزمات مرتبطة بالمناخ في جميع أنحاء المنطقة العربية. وقد تأثرت البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل كثيراً من تزايد هذه المخاطر. فتغير المناخ ليس مقيداً في واقع الحال بالحدود الدولية.
وبين عامي 2015 و2021، زاد كثيراً عدد البلدان في المنطقة العربية التي اعتُبرت فيها مخاطر حدوث أزمة مرتبطة بالمناخ مرتفعة. وفي عام 2015، اعُتبر بلد واحد فقط في المنطقة (الأردن) معرضاً بدرجة مرتفعة لمخاطر الأزمات المرتبطة بالمناخ. وبحلول عام 2021، ارتفع هذا العدد إلى ستة بلدان (الجزائر، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، ودولة فلسطين، وتونس) (الشكل 15).
الشكل 15. مخاطر حدوث أزمة مناخية
وبين عامي 2015 و2021، شهد الأردن والصومال فقط تحسناً في درجة تعرضهما لمخاطر حدوث أزمة مرتبطة بالمناخ. فقد تحسنت مرتبة الأردن من درجة مخاطر مرتفعة إلى درجة مخاطر منخفضة، والصومال من درجة مخاطر متوسطة إلى درجة مخاطر منخفضة. غير أن هذه البيانات لا تبين سوى نقطتين فقط من الوقت (2015 و2021). ومن شأن إجراء تحليل أكثر تعمقاً للاتجاهات أن يكشف عن زيادة واسعة النطاق في مخاطر المناخ في بلدان أخرى في المنطقة. فنظراً للجفاف المستمر مثلاً، من المحتمل أن تكون درجة تعرض الصومال لأزمة مرتبطة بالمناخ قد اعُتبرت مرتفعةً بحلول عام 2023.
2. مخاطر النزاع والحرب والاحتلال
بين عامي 2015 و2021، لم يطرأ تغيُّر مهم على مخاطر حدوث النزاع والحرب والاحتلال في المنطقة العربية (الشكل 16). فالبلدان التي اعتُبرت في عام 2015 معرضةً لمخاطر النزاع والحرب والاحتلال ظلت عموماً على حالها في عام 2021، حيث استمرت النزاعات الطويلة الأمد في جميع أنحاء المنطقة وظلت أسبابها من دون معالجة. وتؤوي هذه البلدان أكثر من ثلث سكان المنطقة. وتُعبّر الحالة في المنطقة أيضاً عن الصلة القوية بين النزاع والتنمية: حيث أن 100 في المائة من السكان في البلدان
الشكل 16.مخاطر النزاع والحرب والاحتلال
المنخفضة الدخل، و94 في المائة من الناس في أقل البلدان نموا، يعيشون تحت رحمة مخاطر النزاع والحرب والاحتلال. وتُعتبر البلدان المرتفعة الدخل إلى حد كبير في منأىً عن مخاطر النزاع والحرب والاحتلال.
3. مخاطر حدوث أزمة اقتصادية
بين عامي 2015 و2021، ارتفع عدد البلدان في جميع أنحاء المنطقة العربية المعرضة لمخاطر الأزمات الاقتصادية ، وكذلك عدد البلدان المعرضة بدرجة منخفضة لمخاطر الأزمات الاقتصادية (الشكل 17). وفي عام 2015، كانت دولة عربية واحدة فقط معرضةً بدرجة مرتفعة لمخاطر الأزمات الاقتصادية. وقد ارتفع العدد إلى بلدينِ بحلول عام 2021. وفي الفترة نفسها، ارتفع عدد البلدان المعرضة بدرجة منخفضة لمخاطر الأزمات الاقتصادية من 15 إلى 17 بلدا.
الشكل 17.مخاطر حدوث أزمة اقتصادية
وبحلول عام 2022، بقي بلدان عربيان معرضين بدرجة مرتفعة لمخاطر الأزمات الاقتصادية، في حين قل عدد البلدان المعرضة لها بدرجة منخفضة إلى 15 بلدا، وهو نفس عددها المسجل في عام 2015.
وتغيرت درجة مخاطر الأزمات الاقتصادية في السودان من متوسطة إلى مرتفعة في عام 2022 حيث عانى من النمو الاقتصادي السلبي، والارتفاع المستمر في التضخم والديون، والاحتياطيات الدولية المحدودة. وفي الفترة نفسها، خرج لبنان من فئة المخاطر «المرتفعة» في عام 2022 لأن ناتجه المحلي الإجمالي نما بنسبة تقدر بنحو 2.7 في المائة. غير أن عواقب الأزمة الاقتصادية الشديدة التي بدأت في عام 2019 ستظل ملموسةً لسنوات عديدة قادمة.
ويظهر الفحص التفصيلي أنه على الرغم من حدوث تغيير طفيف نسبياً بين فئات المخاطر، فإن درجة مخاطر الأزمات الاقتصادية زادت بوجه عام في جميع بلدان المنطقة العربية بين عامي 2015 و2022 (الشكل 18). وقد شكّل ارتفاع التضخم والديون، ولا سيما خلال عامي 2021 و2022، ضغطاً على اقتصادات العديد من البلدان في المنطقة.
الشكل 18.درجة المخاطر الاقتصادية
4. مخاطر حدوث أزمة مؤسسية
بين عامي 2015 و2022، ظلت مخاطر حدوث أزمات مؤسسية مرتفعةً في جميع بلدان المنطقة العربية (الشكل 19). وفي ستة بلدان منها (الجمهورية العربية السورية، والسودان، والصومال، والعراق، وليبيا، واليمن)، ظلت مخاطر حدوث هذه الأزمات مرتفعةً طيلة تلك الفترة.
الشكل 19.مخاطر حدوث أزمة مؤسسية
كما ارتفع، بين عامي 2015 و2021، عدد البلدان المعرضة بدرجة منخفضة لمخاطر الأزمات المؤسسية من ستة بلدان إلى سبعة، حيث انتقلت المملكة العربية السعودية والكويت من فئة المخاطر «المتوسطة» إلى فئة المخاطر «المنخفضة»، وتونس من فئة المخاطر «المنخفضة» إلى فئة المخاطر «المتوسطة».
ب. رسم خرائط مخاطر الأزمات المتشابكة
وجود أي مزيج من أي من أنواع الأزمات الأربعة المذكورة يمثل مخاطر حدوث أزمة متشابكة.
وقد ظلت المنطقة العربية بوجه عام معرضةً بدرجة متوسطة لمخاطر الأزمات المتشابكة بين عامي 2015 و2022. لكن ثمة اختلافات كبيرة بين البلدان، فقد زادت درجة المخاطر «المتوسطة» في المنطقة زيادةً مطردة. وبعبارة أخرى، فإن مخاطر حدوث الأزمات المتشابكة التي تواجه المنطقة العربية زادت زيادةً مطردةً منذ عام 2015.
ويبين الشكل 20 هذه الزيادة بمزيد من التفصيل. ففي عام 2015، كان هناك سبعة بلدان في المنطقة العربية معرضةً بدرجة مرتفعة لمخاطر الأزمات المتشابكة (العراق، وليبيا، ودولة فلسطين، والسودان، والصومال، والجمهورية العربية السورية، واليمن). وبحلول عام 2021، كان لبنان قد دخل مجموعة البلدان المعرضة للمخاطر، ليصل مجموعها إلى ثمانية بلدان. وظلت ستة بلدان معرضة بدرجة منخفضة لمخاطر الأزمات المتشابكة طيلة هذه الفترة.
الشكل 20.البلدان المعرضة لمخاطر الأزمات المتشابكة في المنطقة العربية
ويعرض الشكل 21 المستوى المطلق لمخاطر الأزمات المتشابكة حسب مجموعات البلدان في الأعوام 2015 و2021 و2022. وقد زادت المخاطر بصورة جلية وثابتة خلال هذه الفترة. ويوضح الشكل 22 تغيُّر مستوى مخاطر الأزمات المتشابكة في جميع أنحاء المنطقة.
الشكل 21.مخاطر الأزمات المتشابكة في المنطقة العربية
الشكل 22.رسم خرائط مخاطر الأزمات المتشابكة
وتُعتبر البلدان المرتفعة الدخل إلى حد كبير في منأىً عن مخاطر الأزمات المتشابكة (الشكل 23). وبحلول عام 2022، ظلت البحرين فقط من بينها معرضةً بدرجة متوسطة لمخاطر الأزمات المتشابكة، وذلك بسبب المخاطر الاقتصادية والمتعلقة بالمناخ. أما جميع البلدان الأخرى في هذه المجموعة فكانت معرضةً بدرجة منخفضة لمخاطر الأزمات المتشابكة.
الشكل 23.البلدان المرتفعة الدخل المعرضة لمخاطر الأزمات المتشابكة
ودخلت عُمان لفترة وجيزة في فئة المخاطر «المتوسطة» في عام 2015، على غرار المملكة العربية السعودية في عام 2021. بيد أن كلا البلدين نجحا في خفض درجة المخاطر لديهما بحلول عام 2022. وكانت عُمان أحد بلدينِ فقط في المنطقة – الأردن هو البلد الثاني – انخفضت مخاطر الأزمات المتشابكة فيهما بين عامي 2015 و2021. وفي عُمان، يعزى هذا الانخفاض إلى تحسُّن درجة البلد في مؤشر السلام العالمي، من درجة أعلى بقليل من عتبة المخاطر «المنخفضة» إلى درجة أقل منها بقليل.
الشكل 24.البلدان المتوسطة الدخل المعرضة لمخاطر الأزمات المتشابكة
وفي المقابل، شهدت البلدان المتوسطة الدخل في المنطقة زيادةً مطردةً في مخاطر الأزمات المتشابكة منذ عام 2015. ففي ذلك العام، كانت ثلاثة بلدان (العراق، وليبيا، ودولة فلسطين) معرضةً بدرجة مرتفعة لمخاطر الأزمات المتشابكة. وارتفع عددها إلى أربعة بلدان عندما دخل لبنان إلى فئة المخاطر «المرتفعة» في عام 2021 وظل فيها في عام 2022. كما انخفض عدد البلدان المعرضة بدرجة منخفضة لمخاطر الأزمات المتشابكة من بلدينِ في عام 2015 (المغرب وتونس) وعام 2021 (الأردن وتونس) إلى بلد واحد فقط (الأردن) في عام 2022 (الشكل 24). ويعزى انخفاض مخاطر الأزمات المتشابكة في الأردن في عام 2021 إلى تأثير أقل حدة لتغير المناخ في ذلك العام، لا يُتوقع أن يستمر في المستقبل.
أما جميع البلدان المنخفضة الدخل فقد ظلت معرضةً بدرجة مرتفعة لمخاطر الأزمات المتشابكة طيلة الأعوام 2015 و2021 و2022. لكن مستوى المخاطر التي يتعرض لها كل بلد قد اشتد طيلة هذه الفترة.
الشكل 25.البلدان المنخفضة الدخل المعرضة لمخاطر الأزمات المتشابكة
3. الأزمات المتشابكة وأوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد: حلقة مفرغة
الرسائل الرئيسية
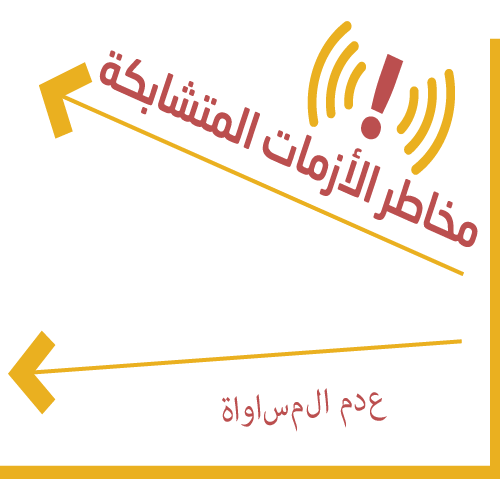
شهدت المنطقة العربية انخفاضاً طفيفاً في أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد بين عامي 2015 و2021، وزيادةً كبيرةً في مخاطر الأزمات المتشابكة.
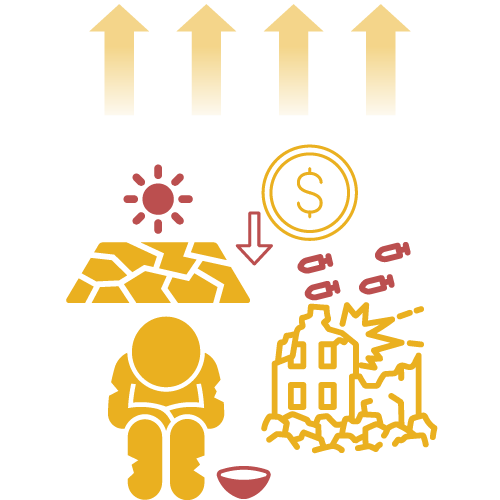
يعيش 39 في المائة من مجموع سكان المنطقة العربية في البلدان المنخفضة الدخل وأقل البلدان نمواً والبلدان المتأثرة بالنزاعات. وقد شهدت هذه البلدان أكبر الزيادات سواء في مخاطر الأزمات المتشابكة أو في أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد.
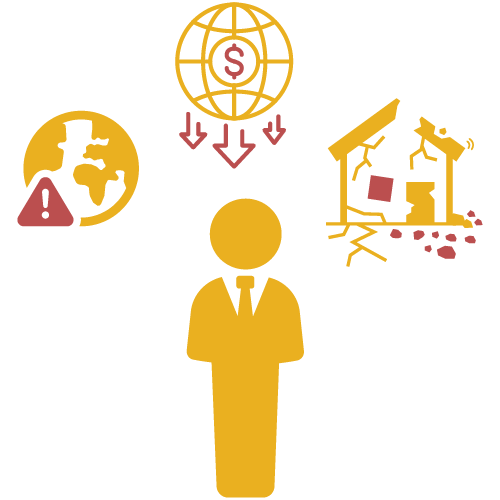
أحرزت البلدان المتوسطة الدخل في المنطقة العربية، التي يعيش فيها 62 في المائة من سكانها، بعض التقدم في الحد من أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد، لكن ازداد تعرضها لمخاطر الأزمات المتشابكة.
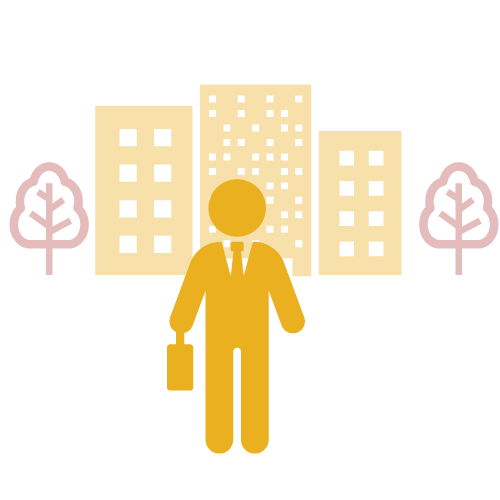
أحرزت البلدان المرتفعة الدخل في المنطقة العربية، التي يعيش فيها 13 في المائة فقط من سكانها، تقدماً في الحد من أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد على الرغم من الارتفاع الطفيف في مخاطر الأزمات المتشابكة فيها. بيد أن هذه المخاطر منخفضةٌ في هذه البلدان.
ترتبط أوجه عدم المساواة والأزمات ارتباطاً وثيقاً. وغالباً ما تفاقم وتعزز بعضها بعضاً.
فإبّان الأزمات، يكون الأشخاص الضعفاء هم الأسرع والأكثر تضرراً. وكثيراً ما تكون قدرتهم على إعادة البناء والتعافي من الأزمة أقل، وفرص حصولهم على الدعم لإصلاح سبل عيشهم أقل. كما قد تؤدي أوجه عدم المساواة في حد ذاتها إلى اندلاع الأزمات من خلال إيجاد اقتصادات ومجتمعات غير مستدامة، ومن خلال تأجيج السخط الاجتماعي.
وتؤدي الأزمات في الوقت ذاته إلى تفاقم الأزمات الأخرى وتعزيزها، وتؤدي أوجه عدم المساواة إلى تفاقم أوجه عدم المساواة الأخرى وتعزيزها. والمزيج النهائي خطير للغاية على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ويستكشف هذا الفصل أولاً العلاقة بين أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد وأنواع الأزمات المبينة في الفصل الثاني. ثم يبرز العلاقة الإيجابية بين أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد ومخاطر الأزمات المتشابكة، والتفاوت في المخاطر بين مجموعات البلدان المختلفة.
أ. الأزمات وأوجه عدم المساواة بالتفصيل
1. الأزمات المناخية وأوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد
يعزز تغير المناخ مواطن الضعف القائمة.
فغالباً ما تمتلك المجتمعات المحلية الأكثر ثراء الموارد اللازمة لتتعافي بسرعة من الكوارث البيئية. أما الفئات المحرومة فقد تكافح لسنوات لتتعافي. وغالباً ما تفتقر المجتمعات المحلية المنخفضة الدخل إلى الوسائل المالية للتعافي من الصدمات البيئية. ويمكن للتكاليف المرتبطة بالكوارث المتصلة بالمناخ، مثل الحاجة إلى إعادة تشييد البنى التحتية أو تأمين سبل عيش بديلة، أن تديم دورات الفقر القائمة وتعمقها.
ويؤثر التدهور البيئي تأثيراً فادحاً على السكان الذين يعيشون في المجتمعات المحلية الريفية، كصغار المزارعين والرعاة، مثلاً. كما أن للجفاف والتصحر ونضوب الموارد الطبيعية تأثيرٌ سلبي على الإنتاجية الزراعية. ونتيجةً لذلك، تنخفض مداخيل المزارعين. وبما أنهم يفتقرون في كثير من الأحيان إلى تدابير التخفيف، فإن هذا يؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة.
كما يمكن أن يؤدي الجفاف وتدهور الأراضي إلى جعل المناطق غير صالحة للسكن، مما يؤدي إلى النزوح والهجرة القسرية. ويعاني النازحون، الذين يفتقرون في كثير من الأحيان إلى الموارد والشبكات الاجتماعية، من تزايد ضعفهم ومحدودية فرص حصولهم على الخدمات الأساسية. وقد يُدفعون نحو المناطق الحضرية المهمشة أو يواجهون مصاعب إضافية أثناء بحثهم عن ملجأ في أماكن أخرى. وهذا يمكن أن يعمق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.
في عام 2022، كان الجفاف يهدد 1.8 مليار شخص، أي ربع سكان العالم. ويقيم ما يقرب من 85 في المائة من المتضررين في البلدان المنخفضة أو المتوسطة الدخل التي تضم غالبية السكان الضعفاء في العالم.
وفي أفريقيا وحدها، تسبب الجفاف في خسائر بقيمة 70 مليار دولار على مدى السنوات الخمسين الماضية، وعرّض 20 مليون شخص لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد أو المجاعة. وتمتد عواقب الجفاف إلى ما هو أبعد من الخسائر الاقتصادية. فنقص المياه لا يمكن أن يترك للناس أي خيار سوى الهجرة، مما يعرضهم لظروف معيشية خطرة. وقد اضطر أكثر من 180,000 شخص بهذه الطريقة على الهجرة من الصومال وجنوب السودان إلى كينيا وإثيوبيا.
أما في المنطقة العربية، فيتحمل القطاع الزراعي وطأة الجفاف. وفي السنوات الأخيرة، عانى المزارعون من أضرار فادحة في محاصيلهم، من تيبُّس بساتين الزيتون في تونس إلى تدمير حقول القمح في الجمهورية العربية السورية والعراق.
وتعد المنطقة العربية من بين أكثر مناطق العالم معاناةً من الإجهاد المائي. وبين عامي 2006 و2010، شهدت المنطقة إحدى أسوأ دورات الجفاف منذ عدة قرون. وفي الآونة الأخيرة، كان عاما 2020 و2021 من بين أكثر الأعوام حرارةً على الإطلاق في المنطقة. والجزائر وموريتانيا والسودان مهددة بوجه خاص بالتصحر، الذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الأراضي الصالحة للزراعة، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، ونزوح المجتمعات المحلية. وقد واجهت الجمهورية العربية السورية والجزائر ولبنان موجات شديدة من حرائق الغابات والجفاف. وفي شبه الجزيرة العربية، أصبحت ظواهر العواصف الرملية والترابية وتفشي الجراد أكثر تواترا، وهي تعزى جزئياً على الأقل إلى تغير المناخ،. وفي البلدان الأخرى، تعاني مصر والمغرب وتونس من تدهور السواحل وارتفاع منسوب مياه البحر.
2. النزاع والحرب والاحتلال وعدم المساواة
العلاقة بين النزاع والحرب والاحتلال وعدم المساواة معقدة ومتعددة الأوجه. فقد يكون عدم المساواة سبباً جذرياً للنزاع، ولكن النزاع قد يسهم أيضاً في أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من خلال تحجيم النمو الاقتصادي، وتدمير سبل العيش والبنى التحتية، والتسبب في النزوح الجماعي، وتحويل وٍجهة الإنفاق الحكومي، وتعطيل توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وعندما تعاني المجتمعات المحلية المهمشة من الإقصاء والتمييز ومحدودية إمكانية الحصول على الموارد، يمكن أن تظهر المظالم وتساهم في الاضطرابات الاجتماعية. كما أن التوزيع غير المتكافئ للثروة والسلطة والفرص يمكن أن يشعل التوترات ويؤجج مطالب التغيير، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى النزاعات والحروب.
ويمكن للنزاع أيضاً أن يزيد من عدم المساواة. فالنزاع يؤدي إلى تحجيم النمو الاقتصادي، وذلك يعزى في جزء منه إلى تعليق النشاط الاقتصادي العادي وتدمير البنى التحتية، وفي جزء آخر إلى انخفاض مستويات الاستثمار في مناطق النزاع. ولهذا التدهور الاقتصادي أثر سلبي على سبل العيش، ولا سيما سبل عيش الفقراء والضعفاء الذين لا يملكون الوسائل اللازمة للهروب بسهولة من مناطق النزاع والاستقرار في أماكن أخرى.
ويفضي النمو الاقتصادي المحدود، وتدمير البنى التحتية، وتحول أولويات التمويل في نهاية المطاف إلى الحد من قدرة الحكومات على إنفاق الأموال على الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الضعفاء اعتماداً كبيراً. ويؤدي تعطيل خدمات الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية الناجم عن ذلك إلى ترسيخ الضعف، وإضعاف الحراك الاجتماعي، وتعزيز عدم المساواة.
وعلى مر السنين، تسببت النزاعات والحروب العديدة في الدمار الهائل والمعاناة الإنسانية والنزوح في المنطقة العربية. ويقبع جزء من المنطقة، دولة فلسطين، تحت الاحتلال منذ 75 عاماً. وغالباً ما يعاني النازحون من تزايد ضعفهم، ومحدودية إمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية، وهشاشة ظروفهم المعيشية.
في نيسان/أبريل 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في البلد. وكان السودان، في بداية عام 2023، وقبل اندلاع موجة العنف هذه، يواجه فعلاً حالة طوارئ إنسانية. وتسببت النزاعات الجارية الأخرى وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والكوارث المناخية في أكبر أزمة إنسانية في السودان منذ أكثر من عقد. كما أدى تجدُّد العنف إلى تفاقم حالة يائسة فعلاً. حيث إن البلد كان قد استنفد بالفعل معظم موارده المتاحة لمعالجة الأزمة.
وبحلول نيسان/أبريل 2024، نزح 6.5 مليون شخص إضافيين داخلياً، وفرّ مليونا شخص آخرين إلى البلدان المجاورة. وكان نحو 25 مليون شخص – أي نصف السكان – بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وعانى 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد. ويعاني واحد من كل سبعة أطفال من سوء التغذية الحاد.
كما أن إمكانية الحصول على الرعاية الصحية محدودةٌ للغاية، حيث بات ثلاثة أرباع المرافق الصحية خارج الخدمة. كما أن إمكانية الحصول على التعليم محدودة أيضا؛ فقد تُرك 12 مليون طفل إضافيين من دون إمكانية الحصول على التعليم، مما رفع العدد الكلي للأطفال غير الملتحقين بالمدارس إلى 19 مليون طفل.
3. الأزمات الاقتصادية وعدم المساواة
غالباً ما تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة، ويمكن أن يكون لها آثار اجتماعية وسياسية بعيدة المدى. وغالباً ما يؤدي الانكماش الاقتصادي إلى فقدان الوظائف وانخفاض الأجور وزيادة معدلات الفقر. وينطبق هذا بوجه خاص على المنطقة العربية، فهي المنطقة الوحيدة التي يتزايد فيها الفقر، ولديها أعلى معدل للبطالة في العالم.
وغالباً ما تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى انخفاض الإيرادات الحكومية وتدابير التقشف وخفض الإنفاق العام. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض في توفير الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم وبرامج الرعاية الاجتماعية. وتتأثر المجتمعات المحرومة التي تعتمد اعتمادا كبيراً على هذه الخدمات أكثر من غيرها، وتزداد أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. ويعيق ذلك أيضاً الحراك الاجتماعي من خلال الحد من فرص الحراك التصاعدي ومحاصرة الأفراد والمجتمعات في دورات الفقر. كما أن مسائل تآكل فرص العمل، وانخفاض فرص الحصول على التعليم والتدريب، ونقص الفرص الاقتصادية تجعل من الصعب على الأفراد تحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.
وكثيراً ما تفتقر الفئات الضعيفة إلى الاحتياطيات المالية والموارد اللازمة لتحمل فترات الانكماش الاقتصادي. ونتيجة لذلك، فإنهم يعانون من انخفاض أعمق في مستويات المعيشة، وانخفاض فرص الحصول على الخدمات الأساسية، وزيادة مستويات الفقر.
وفي أعقاب الأزمة الاقتصادية، يمكن أن تقلل محدودية فرص الحصول على الائتمان والخدمات المالية من قدرة المجتمعات المهمشة على التعافي من الصدمات الاقتصادية أو الاستثمار في فرص جديدة. ويسهم انعدام الأمن الوظيفي وفقدان الدخل الناجم عن ذلك في تزايد التفاوتات في الدخل والثروة.
4. الأزمات المؤسسية وعدم المساواة
شهدت المنطقة العربية في العقد الماضي عدداً كبيراً من الأزمات المؤسسية. ويمكن لهذه الأزمات، التي تتسم بعدم الاستقرار وتحديات الحكم، أن تسهم في التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية القائمة. ويمكنها أن تكون أيضاً سبباً لعدم المساواة في حد ذاته.
وغالباً ما تظهر الأزمات المؤسسية نتيجة لتركز السلطة. ولكن يمكن أن يكون لها تأثير في زيادة تركز السلطة والموارد في أيدي نخبة صغيرة. وهذا يؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة من خلال إقصاء الفئات المهمشة من المشاركة السياسية، مما يقلل من قدرتها على التأثير في صنع السياسات. ونتيجة لذلك، غالباً ما يتم تحويل الموارد العامة بعيداً عن احتياجاتهم. وتتجلى هذه العلاقة في الترابط الإيجابي بين مستويات الدخل ومستوى الثقة في المؤسسات: فأولئك الذين ينتمون إلى الربع الأعلى من أصحاب الدخل يميلون إلى اعتماد نظرة أكثر إيجابية عن المؤسسات من أولئك الذين ينتمون إلى الربع الأدنى.
كما تؤجج الأزمات المؤسسية الانقسامات التي تفتّت المجتمعات وتمنع التماسك الاجتماعي. ويمكن أن تؤدي الخطابات والأفعال المثيرة للانقسام إلى تفاقم التمييز والإقصاء، ولا سيما بالنسبة للفئات الأكثر تهميشاً. وتتعرض المجتمعات المهمشة بدرجة أكبر لمخاطر العنف والتمييز والنزوح في أوقات عدم الاستقرار المؤسسي. وفي الوقت نفسه، قد تصبح النظم القانونية والمؤسسية أقل استجابة أو أكثر تحيزاً أثناء الأزمات، مما يزيد من تهميش الفئات الضعيفة أصلاً.
وكثيراً ما ترتبط الأزمات المؤسسية بالأزمات الاقتصادية. ويؤدي التضخم المرتفع وتدابير التقشف المرتبطة بالأزمات الاقتصادية إلى زيادة السخط الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى اضطرابات شعبية. وقد ارتبطت الزيادة في عدد الاحتجاجات على مستوى العالم في عام 2022 والربع الأول من عام 2023 بارتفاع أسعار الأغذية والطاقة، ومحدودية قدرة الحكومات على حماية سكانها من ارتفاع الأسعار.
ب. الأزمات المتشابكة وأوجه عدم المساواة
أوجه عدم المساواة والأزمات تعزز كل منهما الأخرى. وتزيد أوجه عدم المساواة الراسخة من احتمال حدوث أزمات، في حين تؤدي الأزمات إلى تفاقم أوجه عدم المساواة. وكما يبين الشكلان 26 و27، هناك علاقة إيجابية واضحة بين أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد ومخاطر الأزمات المتشابكة.
وبين عامي 2015 و2021، زادت مخاطر الأزمات المتشابكة في بلدان المنطقة العربية. وعلى الرغم من أن أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد لم تزد بعد، فإن ارتفاع مخاطر الأزمات المتشابكة، والارتباط الإيجابي بينهما، يمثلان خطراً واضحاً يتمثل في زيادة أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد.
وكان هذا الاتجاه ملحوظا بوجه خاص في البلدان المنخفضة الدخل وأقل البلدان نمواً والمتأثرة بالنزاعات. ففي هذه البلدان، تعاظم أثر كل أزمة جديدة، ولا سيما بالنسبة للقطاعات الأكثر ضعفاً من السكان. وكثيراً ما تكون البلدان المتأثرة مقيدةً في استجاباتها بالموارد المحدودة، مما يؤدي إلى إصلاحات قصيرة الأجل تعرّض للخطر التنمية المستدامة الطويلة الأجل وتديم أوجه عدم المساواة بين الأجيال. والنتيجة هي حلقة مفرغة، حيث تتضخم التحديات المجتمعية وتستمر دورات عدم الاستقرار وعدم المساواة.
الشكل 26. مخاطر الأزمات المتشابكة وأوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد في عام 2015
الشكل 27. مخاطر الأزمات المتشابكة وأوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد في عام 2021
وكانت الحالة في البلدان المتوسطة الدخل أقل وضوحاً. ففي لبنان مثلاً، ازداد كل من أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد ومخاطر الأزمات المتشابكة. وفي المغرب، ارتفعت مخاطر الأزمات المتشابكة، لكن أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد انخفضت. وفي الأردن، انخفضت مخاطر الأزمات المتشابكة، لكن أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد زادت. ومع ذلك، شهدت البلدان المتوسطة الدخل مجتمعةً زيادةً كبيرةً في مخاطر الأزمات المتشابكة، التي تجلب معها مخاطر ارتفاع أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد أيضاً في المقابل.
ولدى البلدان المرتفعة الدخل القدرة على الاستثمار في استراتيجيات طويلة الأجل يمكن أن تخفّف من أوجه عدم المساواة بين الأجيال وتعزّز القدرة على الصمود والتنمية المستدامة. ففي الإمارات العربية المتحدة مثلاً، انخفضت أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد ومخاطر الأزمات المتشابكة كلتاهما انخفاضاً ملحوظاً بين عامي 2015 و2021.
ومع ذلك، فإن تزايد مخاطر الأزمات المتشابكة في المنطقة العربية قاطبة، ولا سيما في بلدانها المتوسطة والمنخفضة الدخل، يهدد بتبديد التقدم المحرز في الحد من عدم المساواة. ويؤكد هذا الاتجاه الحاجة الماسة إلى بذل جهود متضافرة لكسر حلقة الأزمات وأوجه عدم المساواة التي تعزز بعضها بعضاً، ولتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة على جميع مستويات المجتمع.
4. طبقات الأزمة
الرسائل الرئيسية
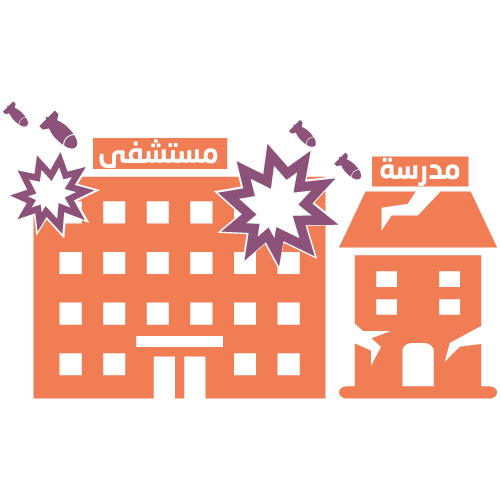
تقوّض الاستجاباتُ القصيرة الأجل للأزمات الاستثماراتِ الإنمائية الطويلة الأجل والاستدامة البيئية، مما يُديم دورات الضعف.
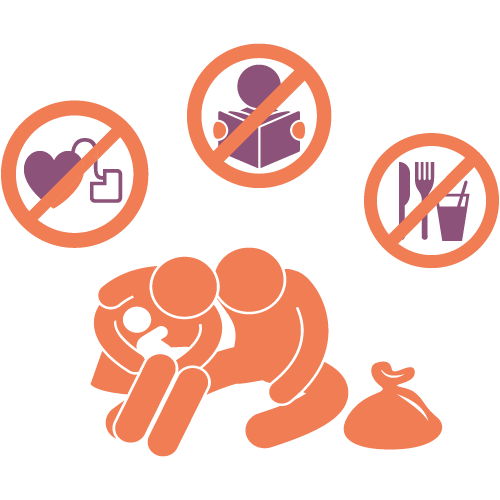
تؤثّر الأزمات المتشابكة تأثيراً أكبر على الأسر الضعيفة وتضطرها إلى التنازل عن ضروريات الحياة مثل وجبات الطعام، والرعاية الصحية، والتعليم، مما يؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة.

يؤدي ضعف الحصائل التغذوية الناجمة عن الأزمات المتشابكة إلى عواقب دائمة على الصحة والنمو المعرفي، مما يديم الفقر المتوارث عبر الأجيال.

في عام 2023، كان 25 في المائة من سكان العالم الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية يعيشون في المنطقة العربية. ولكن هذه المنطقة لم تتلقَ سوى 32 في المائة من التمويل الإنساني اللازم. وذلك دليل على وجود فجوة كبيرة في الدعم، على الرغم من تزايد الاحتياجات.
بعد سلسلة من الأزمات التي شهدتها المنطقة العربية في عام 2023، أصبحت معرضةً لمخاطر الأزمات المتشابكة.
وقد أثّرت أزمات مختلفة على المنطقة العربية في عام 2023. ففي شباط/فبراير 2023، ضربت سلسلة من الزلازل الفتاكة الجمهورية العربية السورية، مما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 6,000 شخص وترك ما يصل إلى 9 ملايين بلا مأوى وبدون مياه شرب أو كهرباء أو وقود للتدفئة. وفي نيسان/أبريل، اندلع القتال في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المتمردة. وبعد مرور عام على بدء العنف، نزح أكثر من 8.5 مليون شخص، ويتعرض الانتقال إلى السلام والديمقراطية في السودان عن طريق التفاوض الدقيق لتهديد خطير. وفي أيلول/سبتمبر، ضربت المنطقة كارثتان طبيعيتان أخريان: الزلزال في المغرب والفيضانات في ليبيا. ففي المغرب، أسفر زلزال قوي عن مقتل 2,500 شخص وإصابة 2,500 آخرين. ودمر الزلزال العديد من القرى الجبلية النائية وترك قرى أخرى يتعذر الوصول إليها بسبب سقوط الصخور عبر طرق الوصول. وفي ليبيا، تسببت العاصفة دانيال في تفجير السدود وتسببت في فيضانات هائلة أودت بحياة أكثر من 11,000 شخص وخلفت 10,000 في عداد المفقودين، ويقدر أنها تسببت في خسائر بقيمة 19 مليار دولار في المباني والبنى التحتية. ودمر الانفجار البنى التحتية الحيوية في منطقة يسكنها 884,000 شخص، من بينهم 353,000 طفل، تاركا الكثيرين دون إمكانية الحصول على الكهرباء أو الماء. وفي تشرين الأول/أكتوبر، اندلعت الحرب في غزة. وكانت درجة الموت والدمار التي تلت ذلك غير مسبوقة في الآونة الأخيرة. وبحلول نيسان/أبريل 2024، قتل أكثر من 34,000 فلسطيني في غزة، 70 في المائة منهم من النساء والأطفال. وأصيب 75,000 آخرون. ويعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي، ويتعرض 1.1 مليون شخص لخطر المجاعة الوشيك.
«اليوم ونحن في منتصف الطريق [صوب تحقيق أهداف التنمية المستدامة]، فإن العالم لا يسير على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف بحلول عام 2030، بل إننا بعيدون عن المسار الصحيح أكثر مما كنّا عليه قبل أربع سنوات. وهذا نذير بأن العالم ما لم يقم بتصحيح مساره على وجه الاستعجال والشروع في تغيير تحويلي، سيخاطر بتبديد التقدم المحرز، وزيادة التعرض للأزمات في المستقبل، وتعزيز مسارات التنمية غير المستدامة».
«وحيثما توقف التقدم أو تباطأ، فإن ذلك يعزى جزئياً لتلاقي الأزمات – كالجائحة المستمرة، وارتفاع التضخم وأزمة تكاليف المعيشة، وضائقة الكوكب البيئية والاقتصادية، إلى جانب الاضطرابات الإقليمية والوطنية والنزاعات والكوارث الطبيعية. إن تداخل هذه الأزمات بلا هوادة قد يبدو من سوء الطالع، لكنها ليست أحداثاً منفصلة. فهي تتضافر من خلال خيوط مادية واقتصادية واجتماعية مختلفة، تؤجج شدة كل منها الآخر».
ولا تزال التهديدات الحالية الناجمة عن الجفاف المتعدد السنوات، وندرة المياه، والنزاعات الطويلة الأمد، والتضخم الجامح، وانهيار العملات، وعدم الاستقرار المؤسسي تؤثر على المجتمعات والاقتصادات والأسر بطرق مختلفة. وقد تفاعلت هذه الأزمات لتسبب أزمات جديدة، مما يمثل مخاطر حدوث أزمة متشابكة.
ويجري توزيع الموارد المالية المحدودة للمانحين على نحو متزايد عبر العديد من الأزمات. وفي الوقت نفسه، أدى أثر هذه الأزمات، بما في ذلك عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي الداخلي، إلى تقليص استثمارات المانحين في القضايا الإنسانية.
وحتى في الحالات التي تدخّل فيها المانحون، اضطرت الحكومات إلى زيادة الإنفاق على حالات الطوارئ الإنسانية، إما بإعادة تخصيص الأموال من الاستثمارات الطويلة الأجل إلى حالات الطوارئ القصيرة الأجل أو بمراكمة ديون إضافية. وفي كلتا الحالتين، تسببت مخاطر الأزمات المتشابكة في تحول تركيز التمويل من التنمية المستدامة الطويلة الأجل إلى الاستجابة القصيرة الأجل لحالات الطوارئ. وينطبق هذا بصفة خاصة على البلدان المنخفضة الدخل، وأقل البلدان نمواً، والبلدان التي تشهد نزاعات، وهي أكثر عرضةً لمخاطر الأزمات ولكن لديها موارد متاحة أقل واحتياجات أكبر لتمويل التنمية المستدامة على الأجل الطويل. ونتيجة لذلك، فإنها تجازف بالتخلف عن الركب في جهودها لتحقيق أهداف خطة عام 2030.
وبالمثل، فإن الأسر المنخفضة الدخل لديها قدرة أقل على الاستجابة للصدمات. وقد حاصرتها سلسلة من الأزمات في دائرة من الاستجابة لاحتياجاتهم القصيرة الأجل بدلاً من الاستثمار في مستقبلهم. فالأزمات تجعل الأسر أقل قدرةً على إعطاء الأولوية لحصول أطفالها على الغذاء والتعليم والرعاية الصحية والسلامة والأمن؛ وهذا من شأنه أن يديم أوجه عدم المساواة بين الأجيال.
أ. استجابات المنظمات الإنسانية للأزمات وأوجه عدم المساواة
إن تعاقب الأزمات التي أثّرت على العالم في السنوات الأخيرة أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب العالمي على المساعدة الإنسانية. وقد انطبق بوجه خاص في المنطقة العربية، التي كانت في عام 2023 تؤوي ربع سكان العالم الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 30 في المائة بحلول نهاية عام 2024.
الشكل 28.الأشخاص المحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في المنطقة العربية
الشكل 29.الاحتياجات المالية للمساعدات الإنسانية في المنطقة العربية
وقد أدت أزمة تلو األخرى إلى انخفاض الموارد المتاحة للمساعدة اإلنسانية ودفعت البلدان إلى تغيير أولوياتها التمويلية، على حساب الدعم اإلنساني العالمي في كثير من األحيان. ونتيجة لذلك، لم يعد باإلمكان الوصول إلى عدد متزايد من المحتاجين، مما يزيد من تضررهم ويعمق عدم المساواة. وهكذا تبدأ حلقة مفرغة: فمع انتشار الحرمان على نطاق واسع وارتفاع عدم المساواة، تزداد مخاطر األزمات المتشابكة والحاجة إلى المساعدة اإلنسانية في المستقبل.
وكما يوضح الشكل ،28 ارتفع عدد األشخاص الذين يحتاجون ً خالل ً كبيرًا إلى المساعدة اإلنسانية في المنطقة العربية ارتفاعًا السنوات المشمولة بالتحليل. فمنذ عام ،2021 استمر عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة اإلنسانية في النمو، ليصل ً أن تقديم إلى 93 مليون شخص في عام .2023 ويظهر العدد أيضًا المساعدات اإلنسانية فشل في مواكبة الطلب المتزايد، حيث ارتفع ،ً ً مطردًا عدد المحتاجين الذين لم يتم استهدافهم بالمساعدة ارتفاعًا ليصل إلى 25 مليون شخص في عام .2022 وفي عام ،2024 من المتوقع أن يرتفع عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية ولم يتم استهدافهم بالمساعدة إلى 29 مليون شخص.
وفي الحاالت التي ال يستهدف فيها المحتاجون بالمساعدة ً ما يكون ذلك بسبب القيود المالية. ويوضح اإلنسانية، غالبًا الشكل 29 كيف نََمت المتطلبات المالية للمساعدات اإلنسانية ً منذ عام ،2015 لتصل إلى 22.9 ً مطردًا في المنطقة العربية نموًا مليار دوالر في عام .2023 غير أنه لم يتم تلقي الكثير من هذا التمويل. وفي عام ،2015 تم تلقي نصف التمويل المطلوب بالضبط؛ وانخفض ذلك إلى 32 في المائة في عام .2023 ولهذا األمر آثاٌٌر واضحة طويلة األجل على األشخاص المستبعدين. وله ً آثاٌٌر طويلة األجل على المنظمات اإلنسانية، حيث تتضاءل أيضًا مصداقيتها وفعاليتها.
ب. االستجابات الحكومية لألزمات وأوجه عدم المساواة
ما تعمل الحكومات على التخفيف من شدة األزمات عند عادًة حدوثها، وتحاول حماية السكان من تأثيرها. فخالل جائحة ً ، ركزت العديد من الحكومات مواردها على تطوير كوفيد-19 مثًال ً عن توفير التأمين ضد البطالة ودعم اللقاحات وتوزيعها، فضًال الشركات وتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي.
بين عامي 2020 و2021، توسّعت فجوة الإنتاجية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية بالقيمة الحقيقية، وذلك من 1:17.5 إلى 1:18، وهي أعلى فجوة منذ عام 2005.
وتهدّد أوجه عدم المساواة في الإنتاجية بين البلدان بتفاقم أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد عن طريق الحد من النمو الاقتصادي والتنمية في البلدان النامية، الأمر الذي سيحدّ بدوره من دخل الأسر والإيرادات الحكومية. ومن شأن افتقار الحكومات إلى الإيرادات أن يضعف قدرتها على توفير الخدمات الأساسية.
الشكل 30.الحيز المالي للبلدان وتعرضها للمخاطر
غير أن نطاق الاستجابات الوطنية كان متفاوتاً. وكما هو الحال بالنسبة لجميع الأزمات، تمكّنت البلدان المرتفعة الدخل من تعبئة التمويل الميسور التكلفة بسرعة وإعادة استثماره في اقتصاداتها ومجتمعاتها. وبفضل ذلك، كان تأثير الأزمة عليها أقصر أجلاً، وتعافيها الاقتصادي أسرع. وفي بعض هذه البلدان المرتفعة الدخل، أسهمت الاستثمارات الحكومية الكبيرة والموجهة خلال الجائحة في التقدم التكنولوجي والبيئي على المدى الطويل.
وفي المقابل، اجتاز العديد من البلدان المنخفضة الدخل الجائحة بعد سنوات من تراكم الديون المطرد، مما لم يترك لها سوى القليل من المرونة أو الحيز المالي لإنفاق الأموال على دعم الفئات الضعيفة. وكما هو الحال في معظم الأزمات، كانت الاستجابات الحكومية في البلدان المنخفضة الدخل محدودةً في كثير من الأحيان. ولا يزال تأثير جائحة كوفيد‑19 ملموساً فيها اليوم، حيث زادت أعباء الديون زيادةً كبيرة، وزادت تكلفة الديون وسط ارتفاع أسعار الفائدة، ولم تحصل الشركات على الدعم للتعافي، مما أدى بدوره إلى ارتفاع معدلات البطالة. وفي أعقاب جائحة كوفيد‑19، أصبح الحيز المالي للحكومات للاستثمار في الخدمات الاجتماعية والاقتصادية أقل حجماً. وقد أدى ذلك إلى تدهور في نوعية الخدمات الاجتماعية، وإلى زيادة مقابلة في أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد.
سعت حكومة الجمهورية العربية السورية إلى إعادة توجيه الإنفاق للحد من أوجه عدم المساواة بين الفئات الاجتماعية الناجمة عن الأزمات المتعاقبة. وفي عام 2023، رفعت الرواتب الحكومية بنسبة 100 في المائة لسد الفجوة بين الأغنياء والفقراء والتغلب على آثار التضخم. وفي أعقاب زلزال عام 2023، وجّهت الحكومة أيضاً جزءا كبيراً من ميزانيتها للتخفيف من آثار الزلزال على المجتمع من خلال بناء وحدات سكنية وتقديم المساعدة المالية للأشخاص المتضررين وذوي الإعاقة.
غير أن الأزمات المتعاقبة حّلت انتباه الحكومة والمجتمعات المحلية، وقللت إلى أدنى حد من فوائد الموارد المحدودة المتاحة للتخفيف من أثر الأزمات. فبدلاً من التركيز على أزمة واحدة أو مجموعة من الأشخاص المحتاجين، يجب توزيع الموارد على عدة أزمات ومجموعات في وقت واحد.
بيد أن التضامن العالمي زاد إلى حد ما في أعقاب جائحة كوفيد‑19. فقد أدرك صانعو السياسات في جميع أنحاء العالم الطبيعة العالمية للجائحة وسعوا إلى تقديم استجابة عالمية. ومع ذلك، لم تحظ أزمات أخرى بنفس القدر من التضامن العالمي بهذه الطريقة. فعلى مدى سنوات، كان قادة العالم يحاولون بناء توافق في الآراء حول استجابة عالمية عادلة لمكافحة تأثير تغير المناخ والحد من انبعاثات غازات الدفيئة. ولكن هذا الإجماع لم يتحقق حتى الآن. كما أن النزاعات أيضاً لا تستقطب استجابةً عالميةً موحدة. فخطر الانجرار إلى النزاع أو الاضطرار إلى اختيار جانب يثني بشدة الجهات الفاعلة العالمية والإقليمية والوطنية عن تقديم الدعم الذي يهدف إلى إنهاء النزاعات. وفي أماكن أخرى، من غير المرجح أيضاً أن تستقطب الأزمات الاقتصادية والمؤسسية، ولا سيما إذا كانت نتيجة لسوء الإدارة، مستوياتٍ كبيرةً من الدعم العالمي أو الإقليمي.
وبالإضافة إلى خفض الإيرادات العامة، أدى تزايد أوجه عدم المساواة إلى إعادة تخصيص حيازات الثروة من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وتؤثر إعادة تخصيص الثروة هذه على الأولويات الوطنية: فهي تجعل الحكومات أقل قدرةً على الاستثمار في الخدمات الاجتماعية، والتخفيف من شدة الأزمات، وتحقيق أهداف خطة عام 2030. ويؤدي تزايد حيازات الثروات الخاصة إلى استثمارات القطاع الخاص على حساب الاستثمارات العامة. وفي بعض الأحيان، يتم تخفيف أثر ذلك جزئياً عن طريق الأعمال الخيرية: أي الأفراد أو الشركات الخاصة الثرية التي تتبرع بالمال لأسباب اجتماعية. ولكن حتى في حالة حدوث ذلك، من غير المرجح أن يتمتع المتبرعون من القطاع الخاص بنفس مدى وصول القطاع العام، وقد يميلون إلى توجيه تبرعاتهم نحو فئات اجتماعية محددة وفقاً لأولوياتهم الخاصة، مما يعرّض التنمية المستدامة الشاملة للخطر.
ولا تؤدي الصدمات المتتالية إلّا إلى التعجيل بهذه الحلقة المفرغة، مما يجعل قدرة الحكومات على التخفيف من أثر الصدمات والاستثمار في الخدمات الاجتماعية التي من شأنها أن تحد من أوجه عدم المساواة لولا ذلك.
والأزمات المتشابكة لها تأثير طويل الأجل. فمع اضطرار الحكومات إلى الاستجابة للأزمات واحدةً تلو الأخرى واشتداد أثر الأزمات المركبة والمتداخلة، تتراجع فعالية استجاباتها. كما أن الاستجابات القصيرة الأجل تأتي على حساب التنمية المستدامة الطويلة الأجل. فزيادة الإنفاق القصير الأجل تتطلب حتماً إما إعادة تخصيص الأموال من الاستثمارات الطويلة الأجل إلى الاستجابة للأزمات في الأمد القريب، أو مراكمة ديون إضافية. ومع ارتفاع أسعار الفائدة، يصبح الحفاظ على الدين العام مكلفاً أكثر فأكثر، ولا سيما بالنسبة للبلدان ذات مستويات الدخل المنخفضة أو ذات المخاطر المرتفعة. ونتيجةً لذلك، يمكن أن تجد البلدان نفسها في حلقة مفرغة من سداد الديون المرتفعة، مما يمنعها من القيام باستثمارات اجتماعية في الأجلين المتوسط والطويل. كما أن أعباء الديون المرتفعة تحد من قدرة البلد المعني على الاستجابة للأزمات في المستقبل: فهي تحد من مقدار الديون الإضافية التي يمكن لحكومته تعبئتها من أجل الاستجابة. كما أنها تجعل الاقتراض في المستقبل أكثر كلفةً: فالبلدان التي تتحمل أعباء ديون مرتفعة لديها مخاطر أعلى، وبالتالي فهي مضطرة إلى الاقتراض بأسعار فائدة أعلى.
ووفقاً للبنك الدولي (الشكل 30)، فإن أربعة بلدان في المنطقة العربية (الصومال والجمهورية العربية السورية والسودان وليبيا) لديها أدنى مستوى من الحيز المالي بين جميع بلدان العالم. أما لبنان فيوجد ضمن المراكز العشرة الأخيرة. وهذا يعني أن قدرة هذه البلدان على دعم التنمية المستدامة الطويلة الأجل محدودة، ولديها تقريبا قدرة على الاستجابة لصدمة أو أزمة إضافية. فإذا ضربت أزمة ما أحد هذه البلدان، فسيكون لها أثر كارثي على سبل عيش سكانه وعلى تنميته المستدامة الطويلة الأجل.
وكثيراً ما تؤدي الاستجابات القصيرة الأجل للأزمات إلى تهميش الأولويات البيئية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب طويلة الأجل على مكافحة تغير المناخ. فعلى سبيل المثال، استأنفت بلدان عديدة تقديم دعمها للوقود للتصدي لأزمة تكاليف المعيشة. وقد يكون هذا الدعم موضع تقدير لدى العديد من الأسر التي ستكافح بدونه من أجل تحمل تكاليف النقل والكهرباء والتدفئة. لكنها استجابة قصيرة الأجل ذات عواقب سلبية طويلة الأجل. ويمثل دعم الوقود تكلفة كبيرة تتحملها الحكومات، ومصدراً آخر للضغط على ميزانياتها المالية؛ كما أنه يهدد عملية الانتقال إلى الطاقات المتجددة ويزيد استخدام الوقود الأحفوري.
ج. استجابات الأسر والأفراد للأزمات وأوجه عدم المساواة
ومن الواضح أن للأزمات المتتالية أثر سلبي طويل الأجل على الأسر. وبين عامي 2015 و2023، وقع 50 مليون شخص في المنطقة العربية في براثن الفقر، وكثير منهم بسبب الصدمات الناجمة عن الأزمات. فانخفاض المداخيل وارتفاع الأسعار يحدّان من قدرة الأسر على شراء الأغذية المغذية، ويجبرانها في كثير من الأحيان على تأجيل العلاج الطبي وعدم إعطاء الأولوية للإنفاق على التعليم. ولهذه القرارات القصيرة الأجل أثر طويل الأجل على تنمية الأشخاص المعنيين وإمكاناتهم على الكسب مدى الحياة. وتتجشم مجموعات معينة وطأة هذا الوضع. إذ يتعرض كل من الأسر المنخفضة الدخل، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعمال غير النظاميين، وفقراء الحضر، واللاجئين، والنازحين داخلياً أكثر من غيرهم لاضطراب نوعية حياتهم في أوقات الأزمات.
وللأزمات تأثير ضارٌ على التغذية. فكثيراً ما يؤدي انخفاض الدخل وارتفاع الأسعار إلى تخطي الأفراد وجبات الطعام أو شراء أغذية أرخص ومغذية أقل، مما يزيد من خطر سوء التغذية. ويضر سوء التغذية ضار بوجه خاص الأطفال والنساء الحوامل؛ ويمكن أن يكون له تأثير مدى الحياة على النمو المعرفي والبدني وصحة الطفل. وغالباً ما تكون النساء في المنطقة العربية آخر من يتناول الطعام، ويؤْثِرن إطعام أسرهن أولاً. وبالتالي فهن أكثر عرضة للمعاناة من حيث التغذية. كما أن فقراء الحضر معرضون بوجه خاص لانخفاض الدخل وارتفاع الأسعار لأنهم لا يستطيعون الحصول على المنتجات الزراعية أو الأراضي لزراعة الأغذية، وبالتالي يتعين عليهم تعديل أنماط استهلاكهم بسرعة، مما يؤدي إلى حصائل تغذوية سيئة.
كما تعيق الأزمات وأوجه عدم المساواة الحصول على الرعاية الصحية. وقد يؤدي التأخير في إجراء الفحوصات، إما بسبب عدم قدرة الفرد على الدفع أو عدم قدرة مقدمي خدمات الصحة العامة على تقديم الخدمات أثناء الأزمات، إلى مضاعفات صحية وتدهور في الصحة على الأجل الطويل. وقد يؤدي انقطاع تقديم الرعاية الصحية إلى إعاقة شديدة للتنقل اليومي للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعتمدون على الأدوية والخدمات الصحية، مما يؤدي إلى عواقب طويلة الأجل على قدرتهم على العمل ونوعية حياتهم بوجه عام.
وكثيراً ما يتعطل التعليم أثناء الأزمات. ويكون ذلك تارةً نتيجة لعدم قدرة الأفراد على دفع تكاليف التعليم. وتارةً أخرى، نتيجة لعدم قدرة الحكومات على الاستثمار في التعليم، مما يؤدي إلى انخفاض نوعيته. وفي بعض الحالات، أن النازحين لم يعد بإمكانهم الوصول إلى المدارس. وفي حالات أخرى، تعني الظروف الاقتصادية للأسرة أن الأطفال (الفتيات في كثير من الأحيان) يضطرون إلى ترك المدرسة لتوليد الدخل لإعالة أسرهم. وبغض النظر عن السبب وراء ذلك، فإن التعليم الضائع له تأثير دائم على إمكانات كسب الأطفال وفرص العمل المتاحة لهم.
وعادةً ما تؤدي الأزمات إلى توسيع الفجوة بين العمال ذوي الأجور المنخفضة والمرتفعة، وبين العمال النظاميين وغير النظاميين. ومن غير المرجح أن يكون لدى العمال غير النظاميين ذوي الأجور المنخفضة ترتيبات عمل مرنة، وفرص أقل للحصول على الحماية الاجتماعية وحماية العمالة. كما أنهم أكثر عرضة لأن يصبحوا عاطلين عن العمل أثناء الأزمات. وهم بالفعل العمال الأكثر ضعفاً، ومن المرجح أن يكونوا الأكثر تضرراً من انخفاض الدخل. ولن تؤدي فترات البطالة المطولة إلّا إلى تفاقم الإقصاء الذي يواجهونه: ففقدان المهارات المصاحب لذلك سيزيد من تقليص رأس مالهم البشري المنخفض، مما يزيد من صعوبة عثورهم على عمل لائق في المستقبل.
في عام 2022، أفاد أكثر من ثلث سكان المنطقة العربية (38 في المائة) أنهم لم يتمكنوا من شراء الأغذية مرةً واحدةً على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية، مع اختلاف بسيط بين الجنسين. وقد ارتفع هذا العدد على نحو مطرد على مدى السنوات الخمس الماضية.
ولا غرابة في أن يكون السكان في أقل البلدان نمواً (جزر القمر، وموريتانيا، واليمن) وفي البلدان المتأثرة بالنزاعات (ولا سيما العراق، وليبيا، ودولة فلسطين، واليمن) هم من يفيدون أكثر بعدم قدرتهم على شراء الأغذية.
وفي اليمن، أفاد أكثر من 70 في المائة من السكان بأنهم لم يتمكنوا من شراء الأغذية مرةً واحدةً على الأقل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، كما أفاد بذلك أكثر من نصف السكان في جزر القمر وموريتانيا والأردن (حيث أدى التدفق الكبير للاجئين إلى زيادة في انعدام الأمن الغذائي). أما في مصر والعراق ولبنان (بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة وارتفاع أعداد اللاجئين) وليبيا والمغرب (بسبب تأثير تغير المناخ على المحاصيل) وفلسطين، فقد أفاد أكثر من ثلث السكان بأنهم لم يتمكنوا من شراء الأغذية مرةً واحدةً على الأقل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.
ولا بد وأن يكون هذا العدد أعلى بكثير اليوم بالنسبة للعديد من بلدان المنطقة، ولا سيما دولة فلسطين، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية، وزيادة الفقر، والنزاعات الدامية.
ويدلّ تزايد الجوع في المنطقة على الأثر الواسع النطاق والكارثي للأزمات المتعددة والمتداخلة وتأثيرها على عدم المساواة. كما أنه ينذر بأن تصبح الأجيال المقبلة أسيرة في أوجه متداخلة من عدم المساواة، ليس أقلها تآكل إمكاناتها الإنتاجية بسبب الجوع.
ربما تكون جائحة كوفيد-19 هي أكثر أزمة موثَّقة على نطاق واسع تؤثّر على التعليم.
غير أن تأثير جائحة كوفيد-19 على إمكانية الحصول على التعليم ونتائج التعلم متفاوت جدار. فقد كان بمقدور الأطفال من الأسر المرتفعة الدخل، الملتحقين بمدارس ذات موارد جيدة، من الانتقال على نحو سلس نسبياً إلى التعلم عن بعد. أما الأطفال من الأسر المنخفضة الدخل والمدارس التي تعاني من نقص الموارد فلم يكن بمقدورهم ذلك.
وتشير التقديرات إلى أن سبعة أشهر فقط من إغلاق المدارس خلال جائحة كوفيد-19 قد تتسبب في زيادة قدرها 10 في المائة في نسبة الطلاب في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الذين يعانون من فقر التعلم – الذي يعرف بأنه نسبة الأطفال في سن العاشرة غير القادرين على قراءة وفهم نص بسيط مناسب لعمرهم. وفي بداية عام 2020، قبل جائحة كوفيد-19، كان معدل فقر التعلم يقدّر بنسبة 53 في المائة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وكان من المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى ما بين 63 و76 في المائة بحلول نهاية عام 2020، حيث كان الأطفال من الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا هم الأكثر تضرراً.
وهذا الجيل من الطلاب معرضٌ الآن لخطر فقدان ما قيمته 17 تريليون دولار من مداخيلهم مدى الحياة بالقيمة الحالية أي ما يعادل 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالقيمة الحالية.
ويمكن أن تؤدي الأزمات أيضاً إلى تفاقم أوجه عدم المساواة التكنولوجية. وقد أحدثت جائحة كوفيد‑19 نقلةً نحو زيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية. وشمل ذلك تحولا في تقديم توفير الحماية الاجتماعية، التي بدأت تدار إلكترونياً وليس مادياً.
ويبشر ذلك بمكاسب كبيرة في الكفاءة وتحسين االستهداف. ً إقصاء بأشخاص مثل العمال غير النظاميين غير لكنه ينذر أيضًا المسجلين في الُُنظم، واألشخاص الذين لديهم إمكانية محدودة للوصول الى التكنولوجيا الرقمية. وبهذه الطريقة، يواجه المهمشون خطر التخلف عن الركب.
ويتأثر اللاجئون والنازحون داخلياً تأثراً بالغاً بالأزمات. فههم يعانون، في أوقات الأزمات، من اضطراب في الحصول على الغذاء والتعليم والرعاية الصحية والمأوى والسلامة والعمل وغيرها من ضروريات الحياة. وكثيراً ما تكون الخدمات المقدمة لهم عندما يستقرون مؤقتاً مكتظة وذات نوعية رديئة. وغالباً ما تكون السلامة أيضاً غير مضمونة. ونتيجة لذلك، غالباً ما تعاني النساء والفتيات من أوجه متداخلة من عدم المساواة: فقد تتعطل إمكانية وصولهن إلى المدرسة أو المرافق الصحية بسبب شواغل تتعلق بالسلامة.
وبالتالي يمكن أن يكون للأزمات عواقب وخيمة طويلة الأجل على أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد، ولا سيما بالنسبة للفئات الضعيفة. ويمكن أن ترافق هذه العواقب الأفراد طيلة حياتهم وتنتقل إلى الأجيال التالية.
5. دراسات الحالة
أ. لبنان: أوجه عدم المساواة تتفاقم
يقبع لبنان حالياً في قبضة أزمات حادة ومتداخلة. وبلغت هذه الأزمات ذروتها في تشرين الأول/أكتوبر 2019، عندما احتجّت أعداد غفيرة من الناس على التدابير التي اقترحتها الحكومة اللبنانية مؤخراً وسط ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، بما في ذلك فرض ضريبة على مكالمات واتساب وضوابط رأس المال على العملاء الذين يصلون إلى مدخراتهم المقومة بالدولار. وسعى المتظاهرون إلى تحقيق تغيير سياسي بعيد المدى، بما في ذلك تحسين احترام الحقوق المدنية والاجتماعية والمساءلة عن الفساد الحكومي وسوء الإدارة.
وبعد ذلك بوقت قصير، وقع لبنان في أزمة اقتصادية ومالية وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. فبين عامي 2019 و2021، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 37 في المائة. وارتفع التضخم على نحو مطرد، وبلغ ذروته عند 171 في المائة في عام 2022، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المائة من قيمتها منذ عام 2019.
تكشف بيانات مؤسسة غالوب عن تشاؤم متزايد حول كيفية رؤية الناس في لبنان لنوعية حياتهم. فعندما عرض عليهم سلّم من 11 درجة لتقييم نوعية حياتهم، أجاب 29 في المائة منهم بأن نوعية حياتهم في أسفل السلم (مقابل 3 في المائة في عام 2015). ولم يبلغ أي من المجيبين في عام 2022 أن نوعية حياتهم كانت في قمة السلم.
ونحو 89 في المائة من الناس في لبنان غير راضين عن مستوى معيشتهم (مقابل 43 في المائة فقط في عام 2015). وأفاد نحو 85 في المائة أنهم يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة بدخلهم الحالي (مقابل 33 في المائة في عام 2015) بينما أجاب 95 في المائة أنه وقت سيئ للبحث عن وظيفة (مقابل 78 في المائة في عام 2015).
وقد فقد الناس في لبنان الثقة إلى حد كبير في نوعية حياتهم في المستقبل. وبحلول عام 2022، كان ما يقرب من ثلاثة أرباع اللبنانيين (74 في المائة) متشائمين بشأن نوعية حياتهم في المستقبل، في حين رأى 32 في المائة من السكان أن نوعية حياتهم ستتدهور على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى أدنى مستوى ممكن. أما في عام 2015، فقد كان 21 في المائة فقط من الناس في لبنان متشائمين بشأن مستقبلهم، وتوقع 4 في المائة فقط أسوأ نتيجة ممكنة لنوعية حياتهم.
الشكل 31. مخاطر الأزمات المتشابكة وأوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد في لبنان (2015-2021)
ملاحظة: تمثل الدوائر الكبيرة لبنان. الرسم البياني مُرمَّز بالألوان حيث يرمز اللون الأخضر إلى مستوى منخفض من مخاطر تعدد أبعاد عدم المساواة ومن مخاطر الأزمات المتشابكة، واللون أصفر إلى مستوى مخاطرهما المتوسط، واللون الأحمر إلى مستوى مخاطرهما المرتفع. وتُصوَّر أي مجموعة مخاطر باعتبارها مزيج الألوان المرتبطة بتلك المخاطر. فمثلا،ً تُعرض درجة مرتفعة من مخاطر الأزمات المتشابكة والمخاطر المتوسطة لتعدد أبعاد عدم المساواة كمزيج من اللونين الأحمر والأصفر: البرتقالي.
كما يعاني لبنان من أزمة لاجئين. وهو يستضيف حالياً نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، مما يجعله أكبر مضيف للاجئين حسب الفرد الواحد في العالم. وأكثر من ربع الأشخاص الذين يعيشون في لبنان هم من اللاجئين. ويمكن لتدفقات اللاجئين إلى الداخل أن تدعم النمو الاقتصادي، ولكن في حالة لبنان، لا يوجد ما يكفي من الموارد والفرص لاستيعاب اللاجئين الذين يعانون الآن من مواطن الضعف الشديدة، والفقر المدقع (الذي يقدر أنه يطال 90 في المائة من اللاجئين على الرغم من الدعم الذي تقدمه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)، ومن القيود المفروضة على حصولهم على الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الأساسية الأخرى. ولم يؤدِّ تأثير جائحة كوفيد‑19 وانفجار مرفأ بيروت إلّا إلى تفاقم الأزمات وأوجه عدم المساواة التي يعاني منها البلد. وبحلول عام 2021، أدى الأثر المركب لهذه الأزمات إلى معاناة 74 في المائة من سكانه من الفقر.
وفي عام 2015، كانت درجة مخاطر الأزمات المتشابكة وأوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد في لبنان متوسطة، على غرار الجزائر والأردن. ومع ذلك، بحلول عام 2021، ارتفعت تلك الدرجة ارتفاعاً كبيراً. وأصبح لبنان البلد الوحيد غير المتضارب في المنطقة الذي يتعرض بدرجة مرتفعة لمخاطر الأزمات المتشابكة.
ويعزى تزايد مخاطر الأزمات المتشابكة في لبنان إلى تزايد مخاطر الأزمات الاقتصادية والمناخية. وفي الوقت نفسه، لا تزال مخاطر حدوث أزمة مؤسسية مرتفعة. كما ازدادت أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد بين عامي 2015 و2021. وكان شكلا عدم المساواة الوحيدان اللذان انخفضا باستمرار خلال هذه السنوات هما عدم المساواة بين الجنسين وعدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية. كما انخفضت أوجه عدم المساواة بين الشباب خلال الفترة نفسها، مع أنه من المتوقع ان تكون قد ازدادت منذ عام 2021 نظراً لتقلص الفرص المتاحة للشباب. وتدهورت إمكانية الحصول على الغذاء، والتمويل، والتكنولوجيا، والمساواة الاقتصادية تدهوراً كبيراً، في حين ظلت إمكانية الحصول على التعليم والحماية الاجتماعية محدودة. ويبين الشكل 32 الأثر العام لذلك على أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد.
وتحسنت المساواة بين الجنسين بين عامي 2015 و2021 مع زيادة نسبة النساء العاملات أو الباحثات عن عمل. كما تحسنت مشاركة الإناث في القوى العاملة، على الرغم من انخفاضها نسبياً، من 26 في المائة في عام 2015 إلى 28 في المائة في عام 2021. وتضاعفت تقريباً نسبة المقاعد البرلمانية التي تشغلها النساء، وإن كانت من مجرد 3 في المائة إلى 5 في المائة. وعلى الرغم من تحسُّن مشاركة النساء في القوى العاملة وتمثيلهن في البرلمان، لا تزال مساواتهن مع الرجال أملاً بعيد المنال.
وأدت الأزمات المتشابكة في لبنان إلى تزايد الأشكال المتعددة لعدم المساواة. فلا تزال إمكانية الحصول على الحماية الاجتماعية والتعليم أكبر مصدرينِ لعدم المساواة في لبنان. وكان ذلك هو حالها بالفعل في عام 2015، لكنها أصبحت أكثر حدةً منذئذ. وخلال الفترة نفسها، شهد لبنان زيادات كبيرة في عدم المساواة في الحصول على الغذاء والتمويل.
الشكل 32. أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد في لبنان
وكانت إمكانية الحصول على الحماية الاجتماعية أكبر مصدر لعدم المساواة في لبنان في عام 2015. وظلت على حالها في عام 2021. وازدادت شدة عدم المساواة في الحصول على الحماية الاجتماعية بين عامي 2015 و2021: إذ انخفضت نسبة السكان الذين تمكنوا من الحصول على ميزة حماية اجتماعية واحدة على الأقل بأكثر من النصف.
فقبل الأزمة المالية، كان نظام الحماية الاجتماعية في لبنان تنازلياً لدرجة كبيرة. إذ كان يعطي الأولوية للتأمين الاجتماعي (الخطط القائمة على الاشتراكات التي كثيراً ما تعتمد على العمالة، مثل المعاشات التقاعدية، والتأمين ضد البطالة، والتأمين الصحي) في شكل معاشات تقاعدية للعاملين في القطاع العام، الذين يمثلون 2 في المائة من السكان ولكنهم يتلقون 93 في المائة من الإنفاق الاجتماعي. وقد ارتفع حجم البطالة والعمل غير النظامي خلال الأزمة، ولكن لم يتم تكييف التأمين الاجتماعي ليراعي ذلك.
وقد طرأ بعض التحسن على المساعدات الاجتماعية (الخطط غير القائمة على الاشتراكات التي تستهدف الأسر المحرومة بشدة، مثل التحويلات النقدية، والقسائم الغذائية، وبدلات الإعاقة)، وهو يعزى جزئياً إلى شدة الأزمات المالية والاقتصادية والمؤسسية المتشابكة التي تواجه لبنان وما يترتب عليها من زيادة ضعف السكان. وفي عام 2021، مع تعمق الأزمة المالية، وضعت الحكومة أول سجل اجتماعي في البلد، وسرعان ما بدأت في تسجيل المستفيدين. وفي غضون شهرين، سجَّل 60 في المائة من سكان لبنان أسماءهم على منصة داعم الإلكترونية، وبحلول أيار/مايو 2023، كانت 145,000 أسرة تتلقى تحويلات نقدية شهرية منتظمة. في الآونة الأخيرة، في نيسان/أبريل 2023، أطلقت الحكومة البدل الوطني للإعاقة، وهو أول مخطط من نوعه في البلد. وأدى ذلك إلى زيادة توسيع نطاق المستفيدين من المساعدة الاجتماعية.
والتحسينات التي حدثت في السنوات الأخيرة ملحوظة. غير أن نظام المساعدة الاجتماعية في البلد يموله بالكامل مانحون خارجيون. وقد أدت الأزمة إلى استنفاد قدرة الحكومة على تمويل أي نظام للمساعدة الاجتماعية بمفردها، مما يعرض استدامة المخططات التي تمولها لخطر شديد. وفي الوقت نفسه، فإن الحد الأدنى من توافر التأمين الاجتماعي يعرض الطبقة الوسطى للخطر ويجازف بدفعها إلى الفقر، حيث تسعى بدلاً من ذلك للاستفادة من برامج المساعدة الاجتماعية التي يمولها المانحون.
أما إمكانية الحصول على التعليم فهي ثاني أكبر مصدر لعدم المساواة في لبنان وقد تدهورت بين عامي 2015 و2021. والناس في لبنان غير راضين على نحو متزايد عن جودة التعليم المقدم في المدارس (الشكل 33). وفي عام 2015، كان معظم الناس في لبنان (74 في المائة) راضين عن نظام التعليم في البلد. وبحلول عام 2022، كان 59 في المائة من السكان غير راضين عنه، ويرى 72 في المائة من السكان أن الأطفال لم تتح لهم الفرصة للتعلم والنمو.
الشكل 33.هل أنت راضٍأم غير راضٍ عن النظام التعليمي في المدينة أو المنطقة التي تعيش فيها؟
وفي عام 2019، تسببت الاحتجاجات الواسعة النطاق في إغلاق المدارس حيث لم يتمكن المعلمون والطلاب من الوصول بأمان إلى المباني المدرسية. وبعد فترة وجيزة من إعادة فتح المدارس، تسببت جائحة كوفيد‑19 في إغلاق المدارس مرةً أخرى. وخلال الجائحة، بدأت العديد من المدارس في الاستفادة من التدريس عبر الإنترنت. وأدى ذلك إلى زيادة عدم المساواة بين الأطفال الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى أجهزة الحاسوب وشبكة الإنترنت الموثوقة والبيئة المنزلية مريحة للتعلم، وأولئك الذين لا يحظون بذلك. وأدت الجائحة إلى تفاقم أوجه عدم المساواة من خلال الحد كثيراً من وصول الأطفال من الأسر الأكثر ضعفا إلى التعليم، مع عدم وجود تأثير يذكر على الأطفال من الأسر الأكثر حظاً. وفي عام 2020 نفسه، ألحق انفجار مرفأ بيروت أضراراً بـ 178 مدرسة رسمية ولا سيما في بيروت (بما في ذلك 91 مدرسة رسمية و70 مدرسة خاصة ومدرستان تابعتان للأونروا)، وأدى إلى تشريد آلاف الأطفال وإصابتهم بصدمات نفسية. وحتى بعد الانفجار، كان سكان بيروت يتمتعون بوصول أفضل إلى التعليم الجيد ممن يعيشون في أماكن أخرى من البلد. فالمدارس الممولة من القطاع العام ومدارس الأونروا التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين لديها نسب طلاب إلى معلمين أعلى بصورة ملحوظة من المدارس الأخرى، مما يحد من الاهتمام الذي يمكن أن يتلقاه أي طالب. وهذه النسب مرتفعة بوجه خاص في محافظات عكار وبعلبك والبقاع.
وجد تحليل لمواقع المدارس وعدد الأطفال الذين يعيشون على مسافة 30 دقيقة مشياً أن جميع الأطفال تقريباً في البلد يمكنهم الوصول إلى المدارس، بصرف النظر عما إذا كانوا يعيشون في مناطق محرومة أو غير محرومة.
وبالتالي، فإن عدم المساواة في الوصول إلى المدارس لا يمثل تحدياً في لبنان. وينبع تزايد عدم المساواة في الحصول على التعليم بالكامل تقريباً من الأزمة المالية، التي لا يتقاضى بسببها المعلمون رواتبهم ولا يستطيع الآباء إرسال أطفالهم إلى المدرسة. وهذه مأساة، ولا سيما بالنسبة للأطفال الذين فاتتهم سنوات من الدراسة. بيد أن هناك أمل في وجود البنى التحتية لإتاحة التعليم بسرعة لجميع الأطفال في لبنان.
كما أثّر انخفاض قيمة العملة بسبب الأزمة المالية على قيمة رواتب مدرسي المدارس العامة. وأدى إلى إضراب المعلمين في عام 2021، مما أسفر مرةً أخرى عن تعطيل تقديم التعليم، خاصة للأطفال الأقل حظاً. وكما أثّرت الأزمة المالية على قدرة الآباء على دفع تكاليف تعليم أطفالهم. ويتسرب الأطفال اللبنانيون من المدارس بأعداد كبيرة للعثور على عمل لإعالة أسرهم. وانخفض معدل الالتحاق بالتعليم من 60 في المائة من الشباب في 2020/2021 إلى 43 في المائة فقط في 2021/2022؛ وفي عام 2022، قال 40 في المائة من الشباب إنهم أو أسرهم خفضوا الإنفاق على التعليم لدفع ثمن الغذاء أو الدواء أو الضروريات الأخرى. ومن غير المرجح أن يجد الأطفال الذين يتركون المدرسة فرص عمل حقيقية، ومن المرجح أن يجدوا أنفسهم بالأحرى أسرى وظائفَ غير نظامية منخفضةِ الأجر، مع تضاؤل فرص تقدمهم الوظيفي. ويفاقم هذا الوضع ويرسخ توارث أوجه عدم المساواة عبر الأجيال: حيث ترتبط مستويات التحصيل العلمي للآباء ارتباطاً وثيقاً بالنتائج التعليمية لأطفالهم. وفي لبنان، فإن 25 في المائة من الأطفال – 15 في المائة من الفتيات و35 في المائة من الفتيان – المولودين لأبوين لديهما مستوى دون المرحلة الابتدائية لن يتجاوزوا هم أنفسهم تلك المرحلة. ولن يرتقي إلى التعليم العالي سوى 30 في المائة من الأطفال المولودين لأبوين لديهما مستوى دون المرحلة الابتدائية (46 في المائة من الفتيات و22 في المائة من الفتيان). أما إذا كان أحد الوالدين قد أكمل التعليم العالي، فثمة احتمال نسبته 0 في المائة بألّا يتجاوز طفله المرحلة الابتدائية، واحتمال نسبته 98 في المائة أن يرتقى طفله أيضاً إلى مرحلة التعليم العالي.
ويشكل تزايد عدم المساواة في الحصول على الغذاء والتمويل تهديداً متزايداً للبنان. وقد تفاقم هذان الشكلان من أشكال عدم المساواة كثيراً بين عامي 2015 و2021. ودخل لبنان على قائمة برنامج الأغذية العالمي للبؤر الساخنة للجوع في عام 2021، بسبب تأثير الأزمات الاقتصادية والمؤسسية المتداخلة، والتي تفاقمت بسبب الجائحة. وبحلول عام 2021، كان 37 في المائة من الشكان في لبنان يعيشون في حالة من انعدام الأمن الغذائي (مقابل 15 في المائة في عام 2015)، في حين كان 11 في المائة منهم يعانون من نقص التغذية (مقابل 6 في المائة في عام 2015). وأدى انهيار العملة ومعدل التضخم المكون من ثلاثة أرقام إلى إغراق غالبية السكان في الفقر وجعل الأغذية غير ميسوره التكلفة بالنسبة للكثيرين. وفي الوقت نفسه، ألغت الحكومة دعم الغذاء والوقود بسبب عدم قدرتها على الدفع. وأدى ذلك إلى زيادة تضخم أسعار الأغذية – الذي بلغ 228 في المائة في نيسان/أبريل 2021 – وانعدام الأمن الغذائي.
بسبب الأزمات المعقدة والمتعاقبة التي ألمّت بلبنان، أصبح المزيد والمزيد من الناس في عداد الضعفاء، بما في ذلك قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى. ولطالما كان المجتمع في لبنان يفتقر للمساواة. غير أن نخبة صغيرة تمكنت من أن تستفيد من هذه الأزمات، وتراكم المزيد من الثروة. وقد أدى ذلك إلى تفاقم عدم المساواة في البلد. فشمال لبنان مثلاً هو موطن أغنى سكانه وأفقرهم.
كما أثّرت الأزمات المعقدة التي ضربت لبنان على المناطق التي تعاني فعلاً من الفقر والحرمان، وتؤوي أعداداً كبيرةً من النازحين، وتقاسي ندرة الخدمات الصحية والتعليمية. فمرجعيون مثلاً هي إحدى قرى محافظة النبطية. ويوجد في البلدة مستشفى حكومي واحد فقط بموارد محدودة تقدم الخدمات لجميع اللبنانيين والنازحين في المنطقة. وفي العديد من المدن في جنوب لبنان، بما فيها صيدا وصور، تُعتبر إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والأدوية ضعيفةً أيضاً بسبب ارتفاع أسعار الخدمات.
وتمثل ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، المسؤولة أساساً عن توفير الدعم والحماية، أقل من 0.5 في المائة من الإنفاق الحكومي. ويُنفق الجزء الأكبر من ميزانية الوزارة على تكاليف التشغيل – لإمدادات الكهرباء والمياه – لمراكز تقديم الخدمات. ولا تعود الأموال المخصصة لتقديم الخدمات بالفائدة على جميع الناس على قدم المساواة. ويفاقم ذلك عدم المساواة بين مختلف الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية.
وفي عام 2015، كان لدى لبنان ثاني أعلى مستوى من الشمول المالي بين البلدان العربية المتوسطة الدخل. ولكن مع ترسخ الأزمة المالية، فُرضت ضوابطُ صارمةٌ على رؤوس الأموال في النظام المالي الرسمي. وسعى الناس إلى التحايل على هذه الضوابط من خلال اللجوء إلى الخدمات المصرفية غير الرسمية. ونتيجة لذلك، أصبح مستوى الشمول المالي في لبنان، بحلول عام 2021، ثاني أدنى مستوى بين البلدان العربية المتوسطة الدخل. وبحلول عام 2021 أيضاً، كان لدى 21 في المائة فقط من البالغين اللبنانيين حساب مصرفي رسمي لدى مؤسسة مالية (مقابل 47 في المائة في عام 2015). تآكلت قيمة المدخرات بالعملة المحلية بسبب التضخم الجامح. وبسبب الضوابط على رؤوس الأموال، لا يمكن الوصول إلى المدخرات بالعملة الأجنبية. وأصبح معظم الناس في لبنان نتيجة لذلك غير قادرين على الادخار أو الاستثمار. وقد أدى ذلك إلى زيادة عدم المساواة الاقتصاد وجعل من المستحيل على العديد من الناس في البلد تمويل الرعاية الصحية والتعليم في حالات الطوارئ.

«يجب أن تكون المدارس العامة والخاصة في علاقة تكاملية [...]. وللحيلولة دون أن يؤدي نظام التعليم إلى تعظيم أوجه عدم المساواة، يجب على المدارس العامة أن تقدّم معايير لجودة التعليم مساوية لتلك الموجودة في المدارس الخاصة».
يونس السلاوي، المدير العام للمدرسة الفرنسية الدولية بالدار البيضاء
ب. المغرب: سياسات مدروسة للحد من أوجه عدم المساواة
في عام 2015، كان المغرب أحد البلدان الثلاثة في المنطقة العربية الأقل عرضةً لمخاطر الأزمات المتشابكة. وكان مستوى المخاطر فيه مماثلاً مستوى البلدان المرتفعة الدخل. وبحلول عام 2021، زاد مستوى المخاطر زيادةً طفيفة تعزى إلى زيادة مخاطر حدوث أزمة مناخية، لكنه ظل منخفضا نسبياً (الشكل 34).
وخلال الوقت نفسه، وفي ظل سياسات مدروسة وهادفة، انخفضت أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد في المغرب انخفاضاً كبيراً (الشكل 35). وقد ازداد شكلان فقط من أشكال عدم المساواة بين عامي 2015 و2021، هما: عدم المساواة في الحصول على الغذاء التي ترتبط ربما بمخاطر تغير المناخ؛ وعدم المساواة بين الشباب، التي تجسد الاتجاه على مستوى المنطقة ككل. وهناك أمثلة عديدة على التزام الحكومة بالحد من عدم المساواة في قطاعات متعددة، بما في ذلك الفجوة بين الريف والحضر، والحصول على الصحة والتعليم، والمساواة بين الجنسين.
وفي عام 2015، كان عدم المساواة في الاقتصاد وفي الحصول على التعليم أهم شكلين من أشكال عدم المساواة التي تواجه المغرب. فالتعليم هو الباعث الأساسي للحراك الاجتماعي. وبالتالي يمكن لعدم المساواة في التعليم ترسيخ عدم المساواة بين السكان وعبر الأجيال. وبين عامي 2015 و2021، وضع المغرب العديد من السياسات الموجهة التي تهدف إلى تحقيق حصول الجميع على التعليم.
الشكل 34. مخاطر الأزمات المتشابكة وأوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد في المغرب (2015-2021)
ملاحظة: تمثل الدوائر الكبيرة المغرب. الرسم البياني مُرمَّز بالألوان حيث يرمز اللون الأخضر إلى مستوى منخفض من مخاطر تعدد أبعاد عدم المساواة ومن مخاطر الأزمات المتشابكة، واللون أصفر إلى مستوى مخاطرهما المتوسط، واللون الأحمر إلى مستوى مخاطرهما المرتفع. وتُصوَّر أي مجموعة مخاطر باعتبارها مزيج الألوان المرتبطة بتلك المخاطر. فمثلاً، تُعرض درجة مرتفعة من مخاطر الأزمات المتشابكة والمخاطر المتوسطة لتعدد أبعاد عدم المساواة كمزيج من اللونين الأحمر والأصفر: البرتقالي.
الشكل 35. أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد في المغرب
وفي عام 2019، سنّ مجلس النواب المغربي قانوناً أرسى أحكام "الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030" ضمن التشريعات. ولقي هذا القانون الترحيب باعتباره ذا دور محوري في الحد من عدم المساواة في الحصول على التعليم في المغرب. وبموجب القانون، سيتم توظيف وتدريب 200,000 من المعلمين الإضافيين. وخفض سن بدء الدراسة الإلزامية من 6 سنوات إلى 4 سنوات، ورفع الحد الأدنى لسن ترك المدرسة إلى 16 سنة. واتخذت خطوات لتسهيل إمكانية الحصول على التعليم المهني، واتخذت تدابير لسد الفجوة في الجودة بين المدارس الخاصة والعامة، التي ينظر إليها على أنها مصدر رئيسي لعدم المساواة في التعليم في المغرب.
وأسفرت هذه السياسات عن زيادة مطردة في عدد المدارس في المناطق الريفية والحضرية على السواء. وبين عامي 2009 و2019، نما عدد المدارس في المغرب بنسبة 15 في المائة. وبحلول عام 2019، كان هناك 5,038 مدرسة حضرية و5,994 مدرسة ريفية في البلد. وزادت ميزانية الحكومة للتعليم أيضاً زيادة متناسبة. وبحلول عام 2021، كان هناك تحسن في مجال الحصول على التعليم أكثر من سائر مجالات عدم المساواة في الإطار المعتمد. ويعزى التقدم المحرز إلى التحسينات الشاملة في معدلات إتمام الدراسة الثانوية، ومعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، وعدد المراهقين غير الملتحقين بالمدارس، والزيادة في الإنفاق الحكومي على التعليم.
كما انخفضت أوجه عدم المساواة في الاقتصاد، وإن بصورة ضئيلة، بين عامي 2015 و2021. ويعزى هذا الانخفاض جزئياً إلى التحسينات التي أدخلت على النظام الضريبي لزيادة الكفاءة والاستدامة والمساواة. وكان الهدف من مشروع قانون المالية لعام 2021 والنموذج التنموي الجديد في المغرب هو تحقيق نظام ضريبي عادل ومتوازن يضمن الاستدامة المالية ويوفر الموارد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع تمكين النمو الاقتصادي المرتفع بقيادة القطاع الخاص. ويركز النموذج التنموي الجديد تحديداً على توسيع القاعدة الضريبية من خلال مكافحة التهرب الضريبي وفرض ضرائب منصفة على القطاع الخاص الأوسع،
المغاربة راضون بوجه عام عن مستوى معيشتهم الحالي ويرون أن نوعية حياتهم تتحسن.
وعلى الرغم من التقلبات الطفيفة، تقدم البيانات بوضوح صورةً إيجابية بوجه عام. وبحلول عام 2022، كان 71 في المائة من المغاربة راضين عن مستوى معيشتهم الحالي. وأعرب 65 في المائة عن اعتقادهم بأنه يتحسن أو سيبقى من دون تغيير.
وضمان كفاءة الإنفاق العام في تحقيق التنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي والتماسك الاجتماعي.
وفي عام 2022، كان المغرب، بفضل الإصلاحات التي أدخلها على نظامه الضريبي، من بين أفضل خمسة بلدان تحسناً على مستوى العالم في "مؤشر الالتزام بالحدّ من انعدام المساواة" لدى منظمة أوكسفام. وارتفع بمقدار 116 مرتبة ليكون الأفضل أداء في العالم في الأداء الضريبي المعزِّز للمساواة.
وازدادت مخاطر عدم المساواة في الحصول على الغذاء في المغرب منذ عام 2015. وترتبط هذه الزيادة ربما بتزايد الخطر الذي يمثله تغير المناخ، وهو خطر ملموس بشدة في المغرب. وأدت الزيادات في مجالي انعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية إلى زيادة عدم المساواة في الحصول على الغذاء بين عامي 2015 و2021. ومن المفارقات أن صادرات البلد من الفواكه والخضروات زادت أيضاً خلال الفترة نفسها (الشكل 36).
وما يفسر هذه المفارقة هو وجود عدم مساواة في النظم الغذائية. فقد تمكنت المَزارع الكبيرة من اعتماد تقنيات وممارسات جديدة ومن تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية. أما صغار المزارعين في المجتمعات المحلية الريفية فلم يتمكنوا من الاستثمار في نُظم وعمليات جديدة، مما يصعب عليهم إطعام مجتمعاتهم المحلية. ومع تدني غلة المحاصيل بفعل تأثير تغير المناخ، تدهورت قدرة صغار المزارعين على الاستثمار في أراضيهم، واتسع نطاق عدم المساواة بين المزارعين. وبالنسبة للمزارعين في المناطق النائية وأكثرهم معاناةً من الإقصاء، فإن العديد من الآليات المتاحة فوراً للاستجابة للأزمة لها تأثير سلبي على آفاقهم على الأجل الطويل. فعلى سبيل المثال، يؤدي بيع المزارعين للماشية أثناء الجفاف بغية شراء الأغذية لأسرهم إلى حرمانهم من الدخل المستقبلي المحتمل المتولد من الماشية.
الشكل 36.تزايدالصادرات الزراعية وانعدام الأمن الغذائي في المغرب
وسنّت الحكومة المغربية العديد من تدابير التكيف والتخفيف للحد من تأثير تغير المناخ على الاقتصاد وعلى السكان الأكثر ضعفاً. وهي تشمل نظم الإنذار المبكر المتطورة للاستعداد للظواهر الجوية المتطرفة، وخطة الاستراتيجية الفلاحية الثانية التي يطلق عليها "الجيل الأخضر 2020-2030". وبموجب هذه الخطة، ستنضم 400,000 أسرة زراعية إلى صفوف الطبقة الوسطى، وسيُقدَّم الدعم لرواد الأعمال الشباب، وسيتم استحداث 350,000 فرصة عمل في الزراعة العالية القيمة.
كما تعكف الحكومة أيضاً على وضع سياسات لتعزيز الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية. وبحلول عام 2030، يهدف المغرب إلى توليد 52 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 42 في المائة، وبدعم جزئي من أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، محطة "نور ورزازات" للطاقة الشمسية. وبالإضافة إلى الحد من الانبعاثات، ستوفر هذه المشاريع كذلك فرص عمل لسكان الريف وتعزز فرص الحصول على الطاقة لمن كانوا محرومين منها في السابق.
تعكف الحكومة المغربية على وضع سياسات لمكافحة تزايد تأثير تغير المناخ، الذي يمثل أحد أكبر مواطن الضعف للبلد. وتشمل تلك السياسات الالتزام بزراعة ملايين الأشجار لتعويض الانبعاثات ومعالجة التصحر وانجراف التربة. وفي ما يلي أدناه ثلاثة أمثلة على ذلك.
فقد التزمت «الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب» (ADM) بتشجير جنبات جميع الطرق السيّارة [السريعة] الجديدة التي تبنيها. وزرعت 3.8 مليون شجرة جديدة على طول 1,100 ميل من الطرق السيَارة الجديدة التي بنتها بين عامي 2014 و2017.
وبالشراكة مع الحكومة، دعم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تدابير إعادة التشجير لاستعادة النظم الإيكولوجية وبناء قدرة المزارعين على الصمود ودخلهم. وفي إطار برنامج التنمية الريفية التابع للصندوق، تم زراعة 270 هكتار من أشجار الخروب، و700 هكتار من أشجار اللوز، و260,000 من أشجار التفاح، و33,000 من أشجار الجوز المزروعة.
ودخلت مؤسسة الأطلس الكبير في شراكة مع المجتمعات المحلية لزراعة أشجار الفاكهة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. وبحلول عام 2021، تم غرس 700,000 شجرة فاكهة و1.6 مليون شتلة بدعم من المؤسسة.
وقد أدى التأثير المشترك لهذه المخططات وغيرها الكثير إلى زيادة الغطاء الشجري في المغرب بمقدار 304 كم2 بين عامي 2015 و2021، ومن المزمع تنفيذ العديد من المشاريع الأخرى.
زيادة الغطاء الشجري في المغرب
ج. اليمن: أوجه عدم مساواة متداخلة مع أزمات
في عام 2015، كان اليمن معرضاً بدرجة مرتفعة لمخاطر الأزمات المتشابكة وكان لديه مستوىً عالٍ من أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد. وبحلول عام 2021، زادت كلتاهما زيادةً كبيرة.
وبحلول عام 2021، لم يكن أي بلد في المنطقة أكثر عرضةً لمخاطر الأزمات المتشابكة من اليمن. وكان لدى بلد واحد فقط، هو الصومال، مستوى أعلى من أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد (الشكل 37). واليمن هو مثال واضح على كيف يمكن لمخاطر الأزمات المتشابكة أن تسيطر على بلد ما حيث تتداخل المخاطر التي يعزز بعضها بعضاً، مع تأثير مدمر على عدم المساواة.
الشكل 37. مخاطر الأزمات المتشابكة وأوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد في اليمن (2015-2021)
ملاحظة: تمثل الدوائر الكبيرة اليمن. الرسم البياني مُرمَّز بالألوان حيث يرمز اللون الأخضر إلى مستوى منخفض من مخاطر تعدد أبعاد عدم المساواة ومن مخاطر الأزمات المتشابكة، واللون أصفر إلى مستوى مخاطرهما المتوسط، واللون الأحمر إلى مستوى مخاطرهما المرتفع. وتُصوَّر أي مجموعة مخاطر باعتبارها مزيج الألوان المرتبطة بتلك المخاطر. فمثلاً، تُعرض درجة مرتفعة من مخاطر الأزمات المتشابكة والمخاطر المتوسطة لتعدد أبعاد عدم المساواة كمزيج من اللونين الأحمر والأصفر: البرتقالي.
لقد قادت تسع سنوات من الحرب الأهلية إلى تآكل القدرة المؤسسية الداخلية وتسببت في تدهور اقتصادي هائل. ومنذ بداية الحرب، انخفض حجم الاقتصاد اليمني إلى النصف نتيجة للقيود المفروضة على التنقل وتدمير البنى التحتية والعنف على نطاق واسع، مما أدى إلى توقف النشاط الاقتصادي. وزادت الحرب من مخاطر الأزمات الاقتصادية والمؤسسية. ولكن هذه المخاطر زادت بدورها من خطر الحرب: فقد أضعفت عمل المؤسسات، مما جعل من الصعب عليها خدمة السكان. ونتيجة لذلك، ازداد اليأس بين السكان، مما زاد من التجنيد العسكري وفاقم من شدة الحرب.
كما أن اليمن معرض بدرجة مرتفعة لتغير المناخ. وأدى ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار إلى زيادة حالات الجفاف والتصحر. وتشير التقديرات إلى أن التصحر وحده يقلل من مساحة الأراضي الزراعية المتاحة في اليمن بنسبة تتراوح بين 3 و5 في المائة كل عام، مما يسهم بصورة مباشرة في انعدام الأمن الغذائي. كما يؤدي التأثير المتزايد لتغير المناخ إلى النزوح الداخلي والجوع والفقر، مما يؤجج المظالم ويزيد من مخاطر الحرب والانهيار الاقتصادي.
وفي اليمن، تعزز ظواهر الحرب والأزمات الاقتصادية والمؤسسية وتغير المناخ بعضها بعضاً إلى حد كبير. ونتيجة لذلك، يواجه البلد واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في العالم. ويحتاج ثلثا سكانه – 22 مليون شخص – إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك 11 مليون طفل. وقد وصف برنامج الأغذية العالمي البلد بأنه بؤرة جوع ساخنة "تثير القلق البالغ" بسبب الأزمة الاقتصادية المتداخلة وانعدام الأمن. وقد نزح شخص واحد من كل سبعة أشخاص – أي ما مجموعه 4.5 مليون شخص. كما نزح العديد من هؤلاء الأشخاص أكثر من مرة. وربع الأسر النازحة ترأسها نساء، وخمس هذه الأسر ترأسها امرأة دون سن 18 عاماً.
ولدى اليمن أعلى مستويات من أوجه عدم المساواة بين الجنسين، وفي الحصول على الحماية الاجتماعية والتمويل في المنطقة. إن عدم المساواة في الاقتصاد وبين الشباب آخذان في الارتفاع، وكذلك عدم المساواة في الحصول على التعليم والحماية الاجتماعية والتكنولوجيا. كما ارتفعت أوجه عدم المساواة في الحصول على الغذاء ارتفاعاً حاداً ولا سيما منذ عام 2015 (الشكل 38).
الشكل 38. أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد في اليمن
وكما هو الحال مع مخاطر الأزمات المتشابكة، فإن كل مصادر عدم المساواة هذه يؤجج بعضها بعضاً. فتزايد عدم المساواة في الحصول على التعليم الذي تعزى إلى تزايد أعداد المعلمين غير المدربين والمراهقين غير الملتحقين بالمدارس، سيجعل الأطفال أرسى حلقة مفرغة من الفقر حيث لن يستطيعوا تحمل تكاليف الحصول على الرعاية الصحية أو الغذاء أو التمويل أو التكنولوجيا. ومع انخفاض إنتاجيتهم الممكنة، فإنهم سيتخلفون عن الركب.
كما ستتسع أوجه عدم المساواة في الاقتصاد، وستستمر الحلقة المفرغة من أوجه عدم المساواة المتزايدة والمتداخلة. ولن يؤدي ارتفاع مستويات عدم المساواة بين الشباب، الناجم عن نقص الفرص المتاحة للشباب، إلّا إلى تفاقم هذا الاتجاه. ومع انخفاض إنتاجية السكان، سيكون لدى الحكومة، المنشغلة بالفعل بأزمة متشابكة، مواردُ أقل متاحة لتوفير الحماية الاجتماعية للسكان المحتاجين يتزايد عددهم.
لقد ضاعف الفقر والنزاع عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس بين عامي 2015 و2021. وقدّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أنه كان يوجد في عام 2021 مليونا طفل في سن الدراسة خارج المدارس (وتقدّر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هذا العدد ارتفع إلى 2.5 مليون طفل في عام 2023). ولم يتسلم ثلثا المعلمين، أو أكثر من 170,000 معلم، رواتبهم بشكل منتظم خلال هذه الفترة، الأمر الذي عرض ما يقرب من 4 ملايين طفل إضافي لخطر فقدانهم فرص الحصول على التعليم.
وأدى الفقر إلى زيادة حالات عمالة الأطفال، والالتحاق بالجماعات المسلحة، وإجبار الفتيات على الزواج المبكر. وفي جميع هذه الحالات، يظل الأطفال حبيسي حلقة مفرغة من الفقر والإمكانات غير المستغلة التي قد تدوم طيلة حياتهم.
ويتضرر الأطفال (الإطار 14) والنساء (الإطار 15) أكثر من غيرهم من جراء تأثير الأزمات المتشابكة على عدم المساواة. فأطفال اليمن ونساؤه هم من بين أكثر الأشخاص معاناةً من سوء التغذية في العالم. ويحتاج نحو 1.3 مليون من الحوامل والمرضعات ونحو 2.2 مليون من الأطفال دون سن الخامسة إلى علاج من سوء التغذية الحاد.
وأدّت الأزمات المتشابكة التي تؤثر على اليمن إلى تعميق أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين، بما في ذلك المشاركة في النشاط الاقتصادي والسياسي. واليمن هو أحد البلدان القليلة في العالم التي ليس لديها نساء في برلمانها. ،
أُدرج اليمن آخر مرة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2021. وفي ذلك العام، كانت أفغانستان فقط أقل من اليمن في التصنيف العالمي للمساواة بين الجنسين. وصُنِّف اليمن من بين البلدان الثلاثة الأدنى مرتبةً على مستوى العالم من حيث المشاركة والفرص الاقتصادية للمرأة. وكان أحد العوامل المساهمة في ذلك هو فجوة الدخل بين الجنسين: ففي اليمن، كان متوسط دخل المرأة 7 في المائة فقط من دخل الرجل. ومن العوامل الأخرى التي أسهمت في ذلك معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة، وهو أحد أدنى المعدلات في العالم. كما صُنِّف اليمن من بين البلدان الثلاثة الأدنى على مستوى العالم من حيث التمكين السياسي للمرأة، ويعزى ذلك جزئياً إلى الغياب التام للوزيرات النساء. وفيما يتعلق بالمساواة في التحصيل العلمي، صُنِّف اليمن من بين البلدان الخمسة الأدنى على مستوى العالم بسبب الاختلاف الكبير في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة والالتحاق بالتعليم العالي بين الرجال والنساء.
وفي عام 2015، كان 29 في المائة من سكان اليمن يعيشون في فقر مدقع. ومنذ ذلك الحين، ازداد الفقر أكثر وأكثر. وبحلول عام 2023، ونتيجة لفقدان فرص العمل والإنتاجية والاستثمار في البلد، كان 75 في المائة من سكان اليمن يعيشون على أقل من 2.10 دولار في اليوم. ولا يؤثر الفقر على جميع الناس على قدم المساواة: فقد زادت أوجه عدم المساواة في الثروة بما يتماشى مع الفقر لتجعل اليمن ثالث أكثر بلدان المنطقة تفاوتاً في توزيع الثروة.
وعندما يزيد الفقر، تزيد الحاجة إلى الحماية الاجتماعية بصورة كبيرة. كما يصبح من الصعب على الحكومات توفير هذه الحماية الاجتماعية. وفي اليمن، لم تبقِ المخاطر المتداخلة للحرب وتغير المناخ والأزمات الاقتصادية والمؤسسية في يد الحكومة سوى الحد الأدنى من الموارد للاستجابة للأزمات المتعددة وحماية الفئات الضعيفة. وتجلى تأثير ذلك في استجابة الحكومة لجائحة كوفيد‑19. حيث لم تتمكن الحكومة إلّا من تنفيذ أربعة تدابير في مجال السياسات لدعم السكان. ولم تبلغ قيمة هذه التدابير سوى 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد. ويؤدي تدمير البنى التحتية أثناء الحرب وارتفاع أعداد النازحين داخلياً إلى زيادة تعقيد عملية توفير الحماية الاجتماعية.
وقد زادت العديد من المنظمات الإنسانية من حضورها في اليمن لسد فجوة الحماية الاجتماعية. لكن جهود هذه المنظمات أيضاً أعيقت بسبب البنى التحتية المدمرة والقيود المفروضة على الأنشطة الإنسانية. فعلى سبيل المثال، مُنعت العاملات في المجال الإنساني من مزاولة عملهن. وقد أعاق ذلك بوجه خاص توفير الخدمات للنساء والفتيات الأخريات. وأدى إغلاق الطرق المحيطة بتعز، ثالث أكبر مدينة في البلد، إلى زيادة صعوبة تقديم المساعدات للسكان الذين يعانون بالفعل من نقص حاد في الغذاء والدواء والسلع الأساسية.
وكان للأزمات المتشابكة وعدم المساواة بين الجنسين وفي الحصول على الحماية الاجتماعية أثرٌ كارثي مشترك على المساواة في الحصول على الغذاء. فأكثر من نصف الناس في اليمن – 17 مليون شخص – يعانون من انعدام الأمن الغذائي. ويعاني 6 ملايين شخص منهم من انعدام الأمن الغذائي الشديد.
وأدى الفقر وارتفاع أسعار الأغذية، التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، إلى جعل الأغذية غير ميسورة التكلفة بالنسبة لغالبية السكان. فقبل عام 2022، كان أكثر من ثلث واردات اليمن من القمح يأتي من الاتحاد الروسي وأوكرانيا. وبحلول نهاية ذلك العام، أفاد أكثر من سبعة من كل عشرة أشخاص في اليمن أنهم لم يتمكنوا من شراء الأغذية مرةً واحدةً على الأقل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية (الشكل 39).
الشكل 39.هل مرّت عليك أوقات في الأشهر الاثني عشر الماضية لم يكن لديك فيها ما يكفي من المال لشراء الأغذية التي احتجت إليها أنت أو عائلتك؟
وتعتمد نسبة كبيرة من السكان اليمنيين على تحويلات المغتربين، أي الأموال التي يرسلها العمال المهاجرون إلى أسرهم في وطنهم. ومنذ جائحة كوفيد‑19، انخفضت قيمة هذه التحويلات.
وقد تفاقم الأمن الغذائي في اليمن بسبب عوامل أخرى مختلفة. فعلى سبيل المثال، أُعيقت قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الأغذية بفعالية بسبب نقص التمويل والقيود التي تفرضها الحكومة. ونتيجة لذلك، يتوقع برنامج الأغذية العالمي أنه ما لم يتم توفير تمويل إضافي، فإنه سيضطر في عام 2024 إلى خفض الحصص الغذائية التي يقدمها إلى 4.4 مليون شخص في اليمن. وأدت ظروف الجفاف في صيف عام 2023 إلى تفاقم الإجهاد الغذائي الذي يعاني منه السكان اليمنيون.
تقدّر الحكومة اليمنية أن ما يصل إلى نصف سكان البلد يتلقون الدعم من تحويلات المغتربين. وتمثل هذه التحويلات أكثر من خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلد.
ويعتمد العديد من الأسر المنخفضة الدخل والضعيفة على تحويلات المغتربين لشراء الأغذية، وتعليم أطفالها، ودفع تكاليف العلاج الطبي. غير أن هذه التحويلات قد تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة.
وتتوقف قدرة المغتربين على إرسال التحويلات على ظروف عملهم. إذ أن العمال المنتمين إلى الأسر الأيسر حالاً غالباً ما يكون رأسمالهم الاجتماعي أكبر، مما يتيح لهم الحصول على فرص عمل أفضل وإرسال المزيد من الأموال إلى الوطن كتحويلات. وبالنظر إلى أن التحويلات تضطلع أيضاً بدور حاسم في تحديد فرص الحصول على التعليم، وبالتالي رأس المال الاجتماعي في المستقبل، فإن ذلك يفاقم أوجه عدم المساواة. وتُعتبر الأسر الأيسر حالاً أقدر على الاحتفاظ برأسمالها الاجتماعي من خلال الاستثمار في التعليم للأجيال القادمة. بينما تفتقر الأسر الأقل حظاً إلى الوسائل اللازمة للقيام بذلك، وبالتالي فهي معرضةٌ لخطر الإهمال .
وإذا ما انخفضت تدفقات تحويلات المغتربين، فقد تؤدي إلى الحد من أوجه عدم المساواة ولكن من خلال زيادة انتشار الفقر، وليس الازدهار.
بين عامي 2021 و2022، نزحت 36,400 أسرة في اليمن داخلياً، ونزح كثير منها نتيجة للنزاع المتواصل.
ويبحث النازحون جراء النزاع في المقام الأول عن الأمان. لكن المواقع التي ينتقلون إليها تفتقر أحياناً إلى البنى التحتية الأساسية لتلبية احتياجاتهم. ويؤدي ذلك إلى تفاقم أوجه عدم المساواة التي يواجهونها. ولذا فقد يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء، والتمويل، والخدمات العامة كالرعاية الصحية والتعليم. وعندما ينقطع الأطفال عن التعليم، فقد يؤثر ذلك تأثيراً شديداً مدى الحياة على نمائهم وفرصهم في المستقبل.
وتظهر الخرائط نقاط مغادرة ووصول النازحين داخلياً في اليمن في عامي 2021 و2022. وتمثل الخطوط الخضراء شبكة الكهرباء في البلد. وتظهر الخرائط بوضوح أن النازحين يميلون إلى الابتعاد عن المناطق ذات البنى التحتية الأساسية للكهرباء، ويصلون إلى مناطق غير متصلة بشبكة الكهرباء الوطنية. ويهدد تدني إمكانية حصول النازحين داخلياً على الكهرباء بزيادة خطر إقصائهم.
د. البحرين: أوجه عدم مساواة تتراجع، ومخاطر تزداد
تبرز البحرين كحالة غير طبيعية في المنطقة العربية، حيث تبدي مزيجاً فريداً من الإنجازات والتحديات في الحد من أوجه عدم المساواة. فمع أن البحرين أحد البلدان الأعلى دخلاً في المنطقة، فإنها كانت على الدوام معرضةً بدرجة متوسطة لمخاطر الأزمات المتشابكة. وقد ازدادت هذه المخاطر مع مرور الوقت. لكن من اللافت للنظر أن البحرين تمكنت من الحد بدرجة كبيرة من عدم المساواة في شتى المجالات، ولا سيما في الحصول على الحماية الاجتماعية والتعليم والمساواة بين الجنسين.
ويكمن أحد النجاحات البارزة للبحرين في نظام الحماية الاجتماعية الشامل، المدعوم بعائدات النفط. وبموجب هذا النظام، يتلقى جميع المواطنين الرعاية الصحية والتعليم مجاناً. كما أنهم مؤهلون للحصول على إعانات الوقود، والأغذية، والمعاشات التقاعدية، والتأمين ضد البطالة. وإبان الجائحة، أُدرج المهاجرون الضعفاء في برامج التأمين الاجتماعي الوطنية. وفي عام 2021، كان ما يقرب من 75 في المائة من الأشخاص فوق سن التقاعد يتلقون معاشاً تقاعدياً.
الشكل 40. مخاطر الأزمات المتشابكة وتعدد أبعاد عدم المساواة في البحرين (2015-2021)
ملاحظة: تمثل الدوائر الكبيرة البحرين. الرسم البياني مُرمَّز بالألوان حيث يرمز اللون الأخضر إلى مستوى منخفض من مخاطر تعدد أبعاد عدم المساواة ومن مخاطر الأزمات المتشابكة، واللون أصفر إلى مستوى مخاطرهما المتوسط، واللون الأحمر إلى مستوى مخاطرهما المرتفع. وتُصوَّر أي مجموعة مخاطر باعتبارها مزيج الألوان المرتبطة بتلك المخاطر. فمثلاً، تُعرض درجة مرتفعة من مخاطر الأزمات المتشابكة والمخاطر المتوسطة لتعدد أبعاد عدم المساواة كمزيج من اللونين الأحمر والأصفر: البرتقالي.
الشكل 41. أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد في البحرين
وعلى الرغم من هذه التطورات، فثمة متسع للمزيد من التحسين، ولا سيما على صعيد تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين ومعالجة المصادر الناشئة لعدم المساواة مثل إمكانية الحصول على التكنولوجيا.
وقد خَطت البحرين، بين عامي 2015 و2021، خطواتٍ واسعةً في مجال المساواة بين الجنسين: فقد تضاعفت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان من 8 في المائة إلى 15 في المائة، وانخفضت بطالة الإناث، وانخفض معدل الولادات لدى المراهقات من 15 ولادة إلى 9 ولادات لكل 1,000 من المراهقات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماً. وكانت البحرين أحد أفضل البلدان تحسناً على المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، مع تحسينات كبيرة في المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة. ومنذ عام 2021، واصلت البحرين تحقيق تحسينات في المساواة بين الجنسين، حيث تضاعف متوسط دخل المرأة من 18,000 دولار في عام 2022 إلى 36,000 دولار في عام 2023. لكن على الرغم من هذه التحسينات، لا يزال متوسط دخل المرأة أقل من ثلثي دخل الرجل.
ولا تزال البحرين تواجه عدداً من التحديات، ولا سيما في ما يتعلق بعدم المساواة بين الشباب.
وعلى الرغم من السياسات الحكومية الواسعة النطاق، فإن خُمسي الشباب فقط – أي ما يقرب من نصف جميع الشبان وربع جميع الشابات – هم جزء من القوى العاملة. ولدى خُمسي الشباب هؤلاء، ارتفعت البطالة من 5.5 في المائة إلى 7.2 في المائة بين عامي 2015 و2021. ولا تزال أوجه عدم المساواة بين الجنسين قائمةً في مجال عمالة الشباب: حيث يبلغ معدل البطالة بين الشابات 14.4 في المائة مقابل 3.3 في المائة بين الشبان.
وقد دفعت قلة فرص العمل في القطاع النظامي العديد من الشباب إلى القطاع غير النظامي، الذي يوظف حالياً ثلث القوى العاملة. ويتقاضى العاملون في وظائف غير نظامية أجوراً أقل من نظرائهم في الوظائف النظامية، وتقل فرص حصولهم على التأمين، مما يجعلهم أكثر عرضةً للأحداث غير المتوقعة. وذلك يعزز من أوجه عدم المساواة القائمة.
وإذا أرادت البحرين الحفاظ على إنجازاتها في الحد من أوجه عدم المساواة، فإن النجاح في إدماج الشباب سيكون أمراً حاسماً. غير أن ديون البلد المتزايدة تمثل تهديداً كبيراً للاستدامة. فبين عامي 2015 و2021، ارتفع عبء ديونه من 66 في المائة إلى 127 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي، مع عبء دين يقدر بنحو 121 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
يظهر البحث تحسُّن حالة أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد في البحرين. كما يشير إلى أن السكان يمكن أن يلمسوا هذا التحسن. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن 81 في المائة من المجيبين في البحرين راضون عن مستوى معيشتهم الحالي، مع اختلاف بسيط بين الرجال والنساء أو بين الشباب وكبار السن.
ويمتد هذا التفاؤل إلى التوقعات بشأن المستقبل: حيث يرى 80 في المائة من المجيبين في البحرين أن مستوى معيشتهم سيبقى على حاله أو سيتحسن في المستقبل، مع وجود اختلاف بسيط بين الجنسين والفئات العمرية.
عانى الشباب في البحرين من قلة الفرص المتاحة لهم بعد التخرج. كما شكّل تنامي القطاع العام خطراً على الاستدامة الاقتصادية للبحرين واستقرارها. وفي عام 2006، أطلقت حكومة البحرين برنامجاً يهدف إلى تحسين هذه الحالة. ويساعد البرنامج، الذي أطلق عليه اسم «تمكين»، المواطنين البحرينيين في الحصول على فرص عمل منتجة، ويدعم القطاع الخاص في خلق وظائف عالية الجودة.
وبالنسبة للأفراد، يقدم البرنامج فرص التدريب، والتوظيف في القطاع الخاص، وتجربة العمل الدولية، وإسداء المشورة لرواد الأعمال. وتشمل فرص التدريب المتاحة تدريب الباحثين عن عمل لأول مرة، ودورات في الإدارة التنفيذية، ودعم تطوير الأعمال لرواد الأعمال، والتدريب في مجال الرقمنة، والدعم الموجه إلى رائدات الأعمال. كما دخل برنامج «تمكين» في شراكة مع تسعة مصارف كجزء من التزامه بدعم إمكانية الحصول على التمويل.
ولدعم القطاع الخاص، يوفر برنامج «تمكين» دعم الأجور للقطاعات التي توظّف البحرينيين. كما يدعم البحث والتطوير لتعزيز الابتكار، ويوفر دعم نموذج الأعمال للشركات المتعثرة، ويقدم التمويل للشركات التي تشجع الرقمنة والتنويع والاستثمار الأجنبي المباشر. كما يدير البرنامج، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، برنامجاً فرعياً متخصصاً لتقديم المشورة التجارية والتمويل لرائدات الأعمال.
ومنذ بدء البرنامج في عام 2006، فقد قدّم الدعم إلى 118,000 من الأفراد و74,000 من الشركات. وقد وفر البرنامج 188,000 فرصة تدريب وتوظيف، ودعم 19,000 من رواد الأعمال في إنشاء أعمال تجارية جديدة. وقد دعمت البرامج الفرعية المخصصة للمرأة 15,466 شركة تقودها نساء، ووفرت التدريب لصالح 53,882 امرأة، واستحدثت فرص عمل لصالح 18,747 امرأة، ودعمت 7,099 من رائدات الأعمال في إطلاق مشاريعهن الخاصة.
وكثيراً ما يرتبط ارتفاع الديون بتزايد أسعار الفائدة على خدمة الديون، وبالتالي ارتفاع مدفوعات الفائدة، مما يحد من قدرة الحكومة على الاستثمار في الخدمات الاجتماعية. وقد أسهمت الاستثمارات في البنى التحتية، بما في ذلك معالجة النقص في المساكن للأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل، إسهاماً إيجابياً في الحد من أوجه عدم المساواة في الحصول على السكن. غير أن جدوى هذه الاستثمارات على الأجل الطويل غير مؤكدة، حيث يحتمل أن يعيق ارتفاع الديون النمو الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص. ويقوّض ذلك بدوره إمكانية استحداث فرص العمل التي تعتبر ضرورياً لإدماج الشباب.
وكان التوسع السريع في تغطية المعاشات التقاعدية في البحرين مثيراً للإعجاب. لكن لا تزال هناك أسئلة حول الاستدامة الشاملة لنظام المعاشات التقاعدية في البلد. فبدون الإصلاحات اللازمة، ستتعرض البحرين لخطر استنزاف صناديق التقاعد بحلول عام 2030، مما يؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة وتهديد رفاه الفئات الضعيفة.
واتخذت البحرين خطواتٍ مهمةً نحو الحد من أوجه عدم المساواة. وتتميز مسيرة البلد بإنجازات ملحوظة تضاءلت بسبب التحديات المستمرة والمخاطر التي تلوح في الأفق. وسيتطلب إحراز تقدم مستدام بذل جهود متواصلة لمعالجة المصادر الناشئة لعدم المساواة، وضمان الاستدامة المالية، وحماية رفاه جميع شرائح المجتمع.
6. العمل اليوم من أجل غدٍ أفضل
أ. مبادئ الحلول الفعالة للسياسات
تتطلب الحقبة الجديدة من الأزمات المتعددة التي تواجهها المنطقة العربية وضع سياسات تعبر عن مدى إلحاح وعمق التحدي الذي تمثله هذه الأزمات. وينبغي توخي الحذر كيلا تقع الحكومات حبيسة عملية لا نهاية لها من صنع السياسات القصيرة الأجل التي تمنعها من تحقيق تنمية المستدامة الطويلة الأجل.
وهناك علاقة يعزز بعضها بعضاً بين مخاطر الأزمات المتشابكة وتعدد أبعاد عدم المساواة. ويقدم هذا القسم من التقرير سلسلة من التوصيات بشأن السياسات المنسقة التي تهدف إلى كسر العلاقة وحماية المساواة في أوقات الأزمات. وينبغي أن تراعي جميع حلول السياسات المقترحة المبادئ الرئيسية التالية.
-
1. الأزمات المتشابكة تتطلب حلولاً متعددة
تؤدي الأزمات المتعددة والمتداخلة إلى أوجه عدم مساواة متعددة ومتداخلة. فالأزمات مترابطة دائما: فليس من الممكن النظر إلى كل أزمة في فراغ، والاستجابة بتدابيرَ علاجيةٍ ضيقةِ الهدف لأزمة واحدة في كل مرة. وأوجه عدم المساواة مترابطة بالمثل. وبالتالي، لا ينبغي لواضعي السياسات أن يحاولوا الاستجابة لبُعد واحد فقط من أبعاد عدم المساواة في كل مرة. بل ينبغي أن يتحول تركيزهم من الحد من الفقر وعدم المساواة في الدخل إلى مكافحة أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد بين جميع الفئات السكان. وهذا النهج وحده قادر على أن يسهم بنجاح في حماية الأمن البشري وتعزيز التماسك الاجتماعي.
-
2. التخطيط المسبق أمر أساسي
لا يعرف أحد متى ستحدث الأزمة القادمة وماذا ستحمل في جعبتها. لكن من المعلوم أن الأزمات والأزمات المتشابكة ستظهر حتماً في المستقبل، وأنها ستفاقم حالة عدم المساواة. فالتخطيط للأزمات أمرٌ أساسي للتخفيف من التأثير السلبي الذي ستحدثه دونما شك. وستكفل خطط الحد من مخاطر الكوارث والاستجابة لها، ونظم الإنذار المبكر وبناء السلام، إذا ما دعمتها آليات تمويل مرنة، إمكانية تقديم الدعم بسرعة وكفاءة وفعالية في أوقات الأزمات.
-
3. لا بد من سياسات وتمويلات مرنة وسلسة
المرونة والسلاسة أمران حاسمان ولا سيما في أوقات الأزمات. وفي الظروف الاستثنائية، ينبغي أن يتمتع صانعو السياسات بالقدرة على وضع تدابير بسرعة لتلبية الاحتياجات الجديدة والناشئة للأشخاص الذين أثرت عليهم الأزمة. ولكي ينجح ذلك، لا بد من توفير التمويل بمرونة وسرعة. ويتطلب ذلك التعاون بين مختلف الوزارات والشركاء الإنمائيين والمجتمع الدولي الأوسع لضمان موافقة جميع أصحاب المصلحة على الخطط والسياسات القائمة ومصادر تمويلها.
-
4. لا بد من تنسيق السياسات
الأزمات المتشابكة لها تأثير معقد ومتعدد الأوجه على عدم المساواة. ويجب أن تأخذ استجابة السياسات الملائمة هذا التعقيد في الحسبان. ولا يمكن للسياسات المعزولة التي تركز تركيزاً ضيقاً على جانب واحد من جوانب الحالة المعقدة أن تكون فعالة في حل الحالة ككل. بالأحرى، يجب تنسيق السياسات، والتعامل مع الوضع من زوايا متعددة. فتنسيق السياسات يقلل من تناقض نتائجها. كما أنه يقلل من ازدواجية الجهود، مما يزيد من فعالية العمل الحكومي وكفاءته. كما أن الالتزام المتسق بالحد من عدم المساواة من خلال التدخلات المنسقة سيبني ثقة الجمهور ويعزز التماسك الاجتماعي.
-
5. لا بد من توطين حلول السياسات ومراعاتها للتطورات العالمية
لا تتأثر البلدان بالقدر نفسه بالأزمات. ولذلك لا يوجد نهج واحد يناسبها جميعاً للتخفيف من آثارها. ويتعين أن تراعي حلول السياسات السياقات المحلية والوطنية، بما في ذلك مسألة ما هي الفئات الضعيفة، وما هي احتياجاتها، وما هي خيارات الاستجابة المتاحة، وكيف يمكن تنفيذها. والتخطيط الفعال الخاص بكل بلد ضروري لضمان أن يعزّز توطين الحلول الكفاءة لا أن يعقد جهود التعافي.
ويعرض القسم التالي من التقرير توصيات في مجال السياسات ترمي إلى حماية المساواة في أوقات الأزمات. وتنقسم المقترحات إلى أربع فئات: (1) الحد من أوجه عدم المساواة بين البلدان؛ (2) الحد من أوجه عدم المساواة داخل البلدان؛ (3) السياسات المصممة خصيصاً للبلدان التي تواجه أوضاعاً خاصة؛ (4) آليات التمويل على الصعيد الوطني.
ب. الحد من أوجه عدم المساواة بين البلدان
تحتاج البلدان إلى السيولة لتمويل عملها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي ظل النظام المالي الدولي الحالي، تتحمل البلدان المنخفضة الدخل أعباء ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يحد من قدرتها على تعبئة الموارد. وينبغي إجراء إصلاحات لخفض تكلفة الاقتراض على البلدان المنخفضة الدخل. ومن شأن زيادة الاقتراض بشروط ميسرة، وتحسين فرص الحصول على أدوات التمويل المبتكرة، وزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية وتدفقات تمويل الأنشطة المناخية من البلدان المرتفعة الدخل إلى البلدان المنخفضة الدخل، أن يمنح البلدان المنخفضة الدخل قدرةً أكبر على تخصيص الموارد لتحسين الإنصاف والاستدامة.
تحد تكاليف خدمة الديون المرتفعة من قدرة العديد من البلدان في المنطقة العربية على الاستثمار بصورة مجدية وتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيها. وفي بعض البلدان، تجاوزت خدمة الديون 50 في المائة من الإيرادات الحكومية. وينبغي للبلدان أن تنظر في أدوات تمويل مبتكرة بما في ذلك مقايضة الديون من أجل المناخ، أو أهداف التنمية المستدامة، أو غيرها من الاستثمارات «الذكية» والخدمات الاجتماعية الأساسية.
في عام 2021، خصص صندوق النقد الدولي 650 مليار دولار إضافية من حقوق السحب الخاصة. غير أن البلدان المنخفضة الدخل لم تتلق سوى 21 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الإضافية. وتلقت البلدان المرتفعة الدخل 433 مليار دولار منها. ويتعين على البلدان المرتفعة الدخل أن تنظر في إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لديها ربما من خلال المصارف الإنمائية الإقليمية لزيادة مستوى الاحتياطيات الأجنبية التي تحتفظ بها البلدان المنخفضة الدخل، وبالتالي الحد من أوجه عدم المساواة بين البلدان.
في الوقت الحالي، يتم تقديم التمويل الدولي من أجل المناخ للمنطقة العربية في الغالب في شكل قروض وليس منح. وهذا يضع عبئاً مالياً كبيراً على الأجيال القادمة. كما أن مستوى التمويل الذي تم توفيره أقل بكثير من مبلغ 570 مليار دولار الذي ستحتاجه بلدان المنطقة لتقديم مساهماتها المحددة وطنياً بشأن العمل المناخي. وينبغي توفير المزيد من التمويل في شكل منح. ومن شأن ذلك أن يزيد من احتمال نجاح بلدان المنطقة في تقديم مساهماتها المحددة وطنياً، وأن يعزز الإنصاف بين البلدان، ويخفف العبء المالي الذي سترثه الأجيال المقبلة.
من شأن مكافحة التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة أن تحمي الإيرادات العامة وتزيد من حجم التمويل المتاح للمعونة الإنسانية والمساعدة الاجتماعية في أوقات الأزمات. كما أنها ستعزز المساواة عبر جعل الأمر أكثر صعوبة على الأثرياء والشركات للاستفادة من الثغرات الضريبية. ويتطلب هذا العمل تنسيقاً عالمياً من الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والمجتمع المدني. وينبغي لكل هذه الجهات الفاعلة أن تضطلع بدور حماسي في هذه العملية. وينبغي أن تكون الحكومات والمؤسسات المالية منفتحةً على تبادل المعلومات المالية، ولا سيما فيما يتعلق بمعاملات الشركات المتعددة الجنسيات. وينبغي لها أن تضع تدابير لإتاحة مزيد من الشفافية فيما يتعلق بملكية المستفيدين. وقد يجعل العمل المنسق على المستوى المطلوب من الضروري إعادة صياغة المعايير الدولية المشتركة لتبادل المعلومات والشفافية والإبلاغ. وينبغي للهيئات المشاركة في وضع هذه المعايير أن تضطلع بدور ملتزم في إحداث التغيير المطلوب. وقد تحتاج بعض البلدان إلى المساعدة في تطوير قدرتها المؤسسية على مكافحة التهرب والتدفقات المالية غير المشروعة. وعلى هذا الصعيد، ينبغي للمجتمع الدولي أن يتدخل ويقدم الدعم بعيد المدى.
يستلزم التعاون في ما بين بلدان الجنوب تبادل المعارف والموارد والخبرات الفنية بين بلدان الجنوب العالمي. وهذا أمر لا يقدر بثمن في تحديد ونشر حلول السياسات التي يمكن أن تنجح في ظل ظروف صعبة، ولا بد من تعزيزه. كما ينبغي للبلدان ذات الظروف والمطالب المتشابهة أن تقيم شراكات جماعية مع البلدان المتقدمة والمنظمات المتعددة الأطراف – وهي ممارسة تعرف باسم التعاون الثلاثي – للحصول على الدعم المالي والتقني في وضع حلول السياسات التي تحد من أوجه عدم المساواة. وبالإضافة إلى توفير فوائد للبلدان المتلقية للمساعدة، فمن شأن ذلك أيضاً أن يزيد من تأثير المساعدة التي تقدمها البلدان المتبرعة.
ج. الحد من أوجه عدم المساواة داخل البلدان
1. حلول سياسات الطوارئ
في أوقات الأزمات، يعدّ توفير المعونة الإنسانية الفورية ضرورياً لتفادي الزيادة الفورية في عدم المساواة. وإذا أريد تقديم المعونة بفعالية وسرعة، لا بد من وضع تدابير التأهب وأفرقة الاستجابة المدربة تدريباً جيداً وتجهيزها. ويقتضي ذلك ضرورة قيام الصناديق والوكالات الإنسانية بتوفير التمويل على الأجل الطويل، وليس فقط في أوقات الطوارئ. ويسمح التمويل الثابت الطويل الأجل للصناديق والوكالات الإنسانية بوضع الخطط وبناء القدرة على الصمود لدى المجتمعات المحلية الضعيفة، مما يقلل من تعرضها للمخاطر على الأجل الطويل واحتياجاتها الإنسانية. كما أنه يمكنها من التصرف بسرعة في أوقات الأزمات. وينبغي ألّا تكون أموال المساعدة الإنسانية ذات دوافع سياسية أو مخصصة لبلد معين. بل ينبغي بالأحرى استخدامها لدعم السكان الأضعف، أينما كانوا وأياً كانت ظروفهم.
تضطلع الخطط الوطنية للاستجابة للكوارث والحد من المخاطر بدور حاسم في الحد من احتمال الأزمات وأثرها. وينبغي وضع هذه الخطط بصورة منتظمة على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي. وينبغي أن تُحدَّث بانتظام وأن تراعي القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وينبغي لها أن تنظر في احتياجات جميع السكان، بما في ذلك الفئات الضعيفة والمهمشة. وينبغي أخيراً أن يرافقها نظام للإنذار المبكر لتزويد المجتمعات المحلية والجهات المستجيبة بمزيد من الوقت لتوقع الأزمة والتخفيف من آثارها المحتملة.
2. حلول السياسات القصيرة الأجل
وينبغي وضع سياسات مرنة للحماية الاجتماعية. ويسمح ذلك بتوسيع نطاق توفير الحماية الاجتماعية بسرعة أثناء الأزمات ليشمل المحتاجين، مما يسهم في انتشال الأفراد من الفقر وتسهيل الحراك الاجتماعي التصاعدي. كما ينبغي لخطط الحماية الاجتماعية أن تنظر مسبقاً في كيفية تأثر الأسر المختلفة بالأزمات المختلفة، وأن يكون لديها خطط احترازية تراعي ذلك.
يمكن لبرامج الأشغال العامة، من خلال توفير النقد أو القسائم أو الغذاء مقابل العمل، أن تصون كرامة الأشخاص في سن العمل ممن تأثروا بالأزمة. ويمكن لهذه البرامج أن تكفل إمكانية توظيفهم في الأجلين المتوسط والطويل، وتحد من تأثير الأزمات على أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد. ويمكن لبرامج الأشغال العامة أيضاً أن تدعم تطوير البنى التحتية في البلدان المتأثرة بالأزمات، مما قد يدعم نموها الاقتصادي إلى حد ما. وينبغي لبلدان المنطقة أن تعتمد هذه البرامج، وينبغي للبلدان المانحة أن تدعمها.
3. حلول السياسات المتوسطة والطويلة الأجل
يمكن أن تؤدي زيادة تغطية التأمين الاجتماعي إلى حماية السكان أثناء الأزمات ومنع تزايد أوجه عدم المساواة. وينبغي تطوير ذلك وترسيخه على الأجل المتوسط، وأن يكون مصحوبا بتدابير تسعى إلى استحداث فرص عمل عالية الجودة، مما يتيح زيادة مساهمات الموظفين في الخطط الوطنية، وبالتالي حماية استدامتها.
التعليم هو أكبر عامل تمكين للحراك الاجتماعي. وينبغي لبلدان المنطقة العربية أن تدرس نظمها التعليمية للتأكد من أنها تلبي تطور متطلبات سوق العمل، بغية تعزيز فرص العمل العالية الجودة في القطاعات السريعة النمو. وينبغي لها أيضاً أن تعزز التعليم مدى الحياة الذي يكفل إبقاء مهارات الناس ملائمة لاحتياجات سوق العمل طيلة حياتهم.
د. السياسات المصممة خصيصاً للبلدان التي تواجه أوضاعاً خاصة
تحتاج البلدان المتأثرة بالنزاعات وأقل البلدان نمواً إلى سياسات مصممة خصيصاً تراعي تزايد مخاطر الأزمات المتشابكة التي تواجهها، وارتفاع درجة أوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد التي يعاني منها سكانها. وكثيراً ما تولّد النزاعات آثاراً غير مباشرة تتجاوز الحدود الوطنية. لذا فإن معالجة الأسباب الجذرية للنزاع والحرب والاحتلال ستعزز التنمية المستدامة والاستقرار دولياً ومحلياً.

عندما تتولى تقديم المساعدات الإنمائية جهةٌ مانحة واحدة، فإنها تبدو وكأنها تحُدُّ من الفساد، وتعزّز الرأي العام، وتحدّ من النزاع. ولكن في تجزئة المانحين، تقل فوائد المعونة بصورة كبيرة.
معهد بيكر فريدمان
يتطلب بناء السلام وتسوية النزاعات التضامن بين مجموعات من الناس تتعارض وجهات نظرهم واحتياجاتهم بشدة في بعض الأحيان. ولا يمكن أن تنجح العملية إلّا إذا تم استيفاء مجموعة معقدة من المتطلبات. وهي تشمل الضمانات الأمنية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، والالتزام بحقوق الإنسان. وينبغي للحكومات أن تستثمر الموارد لتهيئة الساحة لبناء السلام بنجاح. وينبغي لها أن تكفل استدامة العملية، وأن تطبق نهجاً تصاعدياً يشمل ممثلين من جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب.
يتناول هدف التنمية المستدامة 16 المؤسسات القوية الضرورية للسلام. وعلى الحكومات في المنطقة العربية اتخاذ خطوات لتعزيز المؤسسات حتى تتمكن من الاضطلاع بدور فعال في منع العنف ودعم سيادة القانون وحقوق الإنسان. وينبغي للمجتمع الدولي أن يغتنم كل فرصة سانحة للإسهام في هذا الشكل الحاسم من أشكال بناء القدرات.
في بعض الأحيان، يتفاعل مانحون متعددون مع الأزمات من خلال الاستثمار بكثافة في مبادرات متداخلة. وتؤدي أولوياتهم المتنافسة إلى تعقيد جهود التنسيق، كما أن التدفقات الكبيرة من الموارد أكثر صعوبة في التدقيق. وتتجلى هذه الظاهرة، التي يطلق عليها تعبير تفتُّت المعونة، أكثر ما تتجلى في البلدان التي تشهد نزاعات. وينبغي ألّا يستجيب المانحون لهذه المسألة بتخفيض استثماراتهم في البلدان المتأثرة بالنزاعات. بل ينبغي أن يحسّنوا تنسيقها ويتخذوا خطوات تهدف إلى تجنب تداخل أولويات التمويل.
ه. آليات التمويل على الصعيد الوطني
تتطلب جميع التوصيات المتعلقة بالسياسات المقترحة أعلاه التمويل. وبالنسبة لمعظم الحكومات، فإن المصدر الرئيسي لهذا التمويل هو الإيرادات الضريبية. والمساواة في المجتمع تحفز مستويات أعلى من الإيرادات الضريبية. وفي مجتمع يتمتع بمساواة أكبر، يكون المزيد من الأفراد مسؤولين عن دفع الضرائب، وبالتالي يزداد مقدار الإيرادات المحصلة. أما زيادة أوجه عدم المساواة فلها أثر معاكس، إذ تحدّ من قدرة الحكومات على تمويل التدابير التصحيحية. وتمثل الضرائب التصاعدية وسياسات إعادة التوزيع عاملاً أساسياً في الحد من أوجه عدم المساواة في الأجل المتوسط. ويمكن أن تضطلع زيادة إيرادات الضرائب على الشركات بدور مهم في زيادة الإيرادات الضريبية الإجمالية وتعزيز المساواة، ولا سيما إذا ركزت الحكومات على الشركات المتعددة الجنسيات بدلاً من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وينبغي إعادة توزيع الضرائب المحصلة من الضرائب التصاعدية على الأسر المنخفضة الدخل والضعيفة وفقاً لاحتياجاتها. ويمكن أن تكون التحويلات النقدية وسيلةً فعالةً للحد من أوجه عدم المساواة. كما يمكن للاستثمارات الفعالة في الخدمات العامة الجيدة أن تسهم إسهاماً كبيراً في إيجاد مجتمع يتمتع بقدر أكبر من المساواة.
عادةً ما تكون الضرائب غير المباشرة تنازلية: أي أن لها بعبارة أخرى تأثيراً أكبرَ نسبياً على الفقراء من الأغنياء. فعبء ضريبة القيمة المضافة مثلاً، أثقل بكثير على الأسر المنخفضة الدخل لأنها تنفق نسبةً أكبر من دخلها من الأسر الأيسر حالاً القادرة على الادخار والاستثمار. وإذا ارتأت الحكومات فرض ضرائب غير مباشرة، فينبغي لها أن تسعى إلى جعلها أكثر تصاعدية. فيتعين عليها مثلاً تطبيق معدلات ضريبة أقل على السلع الأساسية كالأغذية ومعدلات ضريبة أعلى على السلع الكمالية. بيد أنه ينبغي للحكومات، على الوجه الأمثل، أن تتجنب الضرائب غير المباشرة قدر الإمكان. ويجب عليها بالأحرى فرض ضرائب مباشرة مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات. ويمكن لهذه هذه الضرائب أن تعزز المساواة إذا ما فُرضت بمعدلات أعلى نسبياً على الأشخاص ذوي الدخل المرتفع وعلى أصحاب الأرصدة الضخمة من الأفراد والشركات.
يمكن أن توفر تحويلات المغتربين شريان حياة للأسر المتأثرة بالأزمات. لكنها، ما لم تُدر إدارةً جيدة، قد تُديم أوجه عدم المساواة. ويقوم مرسلو التحويلات الأكثر ثراءً بإرسال مبالغ أكبر بصورة غير منتظمة نسبياً وعبر القنوات الرسمية. أما مرسلوها الأقل ثراء فيرسلون مبالغ أصغر بصورة منتظمة أكثر عبر قنوات غير رسمية، ويخسرون نسبةً أكبر بكثير من تحويلاتهم على تكاليف المعاملات. ويتحمل هذه الخسارة غير المتناسبة متلقو التحويلات الذين غالباً ما يكونون أيضاً أقل ثراء. ويمكن أن يؤدي خفض تكلفة معاملات التحويلات إلى تعزيز المساواة وجعل التحويلات أكثر فعالية في دعم الأسر التي لا تصل إليها الحماية الاجتماعية بصورة كافية.
يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تدار إدارةً سليمة أن تزيد من الكفاءة في توفير البنى التحتية العامة. فهي تتيح للحكومات الاستفادة من ابتكارات القطاع الخاص وخبراته، والوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال، وتقاسم مخاطر الاستثمارات الكبيرة. وينبغي للحكومات أن تسعى إلى إرساء شراكات مع القطاع الخاص لتوسيع نطاق توفير المنافع العامة، بما فيها البنى التحتية الأساسية.
يلتزم التمويل الإسلامي بالمعايير الأخلاقية العالية تجاه الناس والبيئة. وهناك أدلة متزايدة على إمكانية إدخال عناصر من التمويل الإسلامي عبر النظام المالي العالمي، بما في ذلك في البلدان غير الإسلامية. وتنطوي هذه الخطوة على إمكانات كبيرة للحد من الفقر وزيادة المساواة. ولا تزال هناك مجالات يمكن للتمويل الإسلامي أن يشملها، بما في ذلك توفير الائتمان القائم على الأسهم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع البنى التحتية الكبيرة. وفي عام 2020، بلغت قيمة أصول التمويل الإسلامي 3.4 تريليون دولار. وفي المنطقة العربية على وجه الخصوص، ينبغي أن يسعى صانعو السياسات إلى زيادة استخدام أساليب التمويل الإسلامي بغية الحد من أوجه عدم المساواة.
